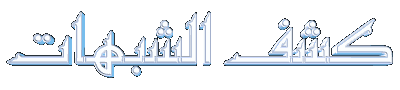|
التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية
للدكتور صالح بن فوزان
الفوزان
ا 1
ا 2 ا
3 ا
4 ا
5 ا (122)
ونؤمن بالملائكة والنبيين:
هذا من أركان الإيمان، التي أولها: الإيمان بالله، وثانياً: الإيمان
بالملائكة، وهم عالم من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى،
خلقهم الله تعالى من النور؛ لعبادته وتنفيذ أوامره في مخلوقاته، أوكل
إليهم أعمالاً يقومون بها وينفذونها في مخلوقاته، منهم الموكل بالوحي،
ومنهم الموكل بالقطر والنبات، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل
بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، ومنهم الموكل
بالجبال، ومنهم الموكل بالأجنّة في بطون الحوامل، كما في حديث ابن مسعود
(ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد) ( ) .
فهم موكلون بأعمال يقومون بها كما أمر الله تعالى بها: (لا يسبقونه
بالقول وهم بأمره يعملون) [الأنبياء:27]، (يسبحون الليل والنهار لا
يفترون) [الأنبياء:20].
فهم يعبدون الله عبادة متواصلة ومع ذلك يقومون بما أوكل إليهم من تنفيذ
الأوامر في المخلوقات ولهم مهام عظيمة، وخلقتهم لا يعلمها إلا الله
سبحانه وتعالى( )، تختلف عن خلقة بني آدم (جاعل الملائكة رسلاً أولى
أجنحة مثنى وثلاث ورباع) [فاطر:1] ولبعضهم أكثر من ذلك (يزيد في الخلق ما
يشاء) [فاطر:1] فجبريل عليه السلام له ستمائة جناح، كل جناح منها سد
الأفق، فلا يعلم خلقتها ولا كيفيتها إلا الله. أما البشر فلا يستطيعون
رؤية الملك على صورته، وإنما يأتي الملك في صورة إنسان كما كان جبريل
يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، ويجلس إليه ويكلمه،
ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية إلا مرتين، مرة وهو
في بطحاء مكة رآه في الأفق، ومرة عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء
والمعراج، وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل يأتي النبي صلى الله عليه
وسلم في صورة إنسان، وكثيراً ما يأتي في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه.
وقوله: (والنبيين) النبيين جمع نبي وهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر
بتبليغه، والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ويجب الإيمان بجميع
الأنبياء والمرسلين ومن آمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع (لا
نفرق بين أحد من رسله)
(123) والكتب المنـزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين:
من أصول الإيمان وأركانه: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل
لهداية الخلق؛ فالله تعالى أنزل الكتب على الرسل من كلامه ووحيه وتشريعه،
أنزلها على الرسل ليبلغوها إلى أممهم، فيها الأوامر وفيها النواهي، وفيها
شرع الله جل وعلا.
منها ما سماه الله في القرآن ومنها ما لم يسمه، ونحن نؤمن بجميع الكتب،
ما سماه لنا وما لم يسمه، كالتوراة التي أنزلها على موسى، والإنجيل الذي
أنزله على عيسى، والقرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم،
والزبور الذي أنزله على داود (وآتينا داود زبورا) [النساء:163] وصحف
إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فنؤمن بها كلها وأنها في مصلحة الخلق
وهداية الخلق وإقامة الحجة، فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر
بالجميع؛ لأنها كلها من كلام الله فلا يجوز الإيمان ببعضها والكفر بالبعض
الآخر، قال تعالى: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل
ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا) [البقرة:85].
وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله والعمل به كله، فلا نأخذ ما
يوافق شهواتنا وندع ما يخالفها .
فمن جحد كتاباً من كتب الله، أو بعضاً من الكتاب، أو كلمة من الكتاب، أو
حرفاً من الكتاب، فهو كافر بالله عز وجل.
(124) ونسمّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين:
هذا من العقيدة، أنه من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم، ولو
صدر منه بعض المعاصي، ولو كانت من الكبائر، وما دامت المعاصي دون الشرك،
ولكن يكون مسلماً ناقص الإسلام وناقص الإيمان وفاسقاً، ولكنه لا يُحكم
بكفره إن كانت معاصيه دون الشرك، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا
يُكفِّرون بالمعاصي التي هي دون الشرك، ولكن ينقص بها الإيمان، وصاحبها
يفسق بها الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الملة. خلافاً للخوارج الذين
يُكفّرون بالكبائر ويخرجون بها من الملة، ويخلدون صاحبها في النار.
وخلافاً للمعتزلة الذين يُخرِجون صاحب الكبيرة من الإسلام، ولكن لا
يدخلونه في الكفر، ويقولون: هو في منـزلة بين المنـزلتين، ولكن لو ماتوا
على الكبيرة فالمعتزلة مثل الخوارج في الحكم عليهم، وخلاف عقيدة المرجئة
الذين يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية، من صدق بالله عز وجل فإنه
يكون مؤمناً، وإن فعل ما فعل، ولو ترك جميع أركان الإسلام عندهم لا يكون
كافراً، المهم التصديق والاعتقاد، أما الأعمال فلا تزيد في الإيمان ولا
تنقصه وليست منه، فهو مؤمن تام الإيمان ما دام مصدقاً.
هذا مذهب المرجئة، وهو مذهب ضال.
فهم مع الخوارج على طرفي نقيض؛ قوم تشددوا، وهم الخوارج، وقوم ذابوا
وماعوا وقالوا: إن هذه المعاصي لا تضر، وهم المرجئة، وأما أهل السنة
والجماعة فتوسطوا، ومذهبهم مأخوذ من الكتاب والسنة، وهو العدل، وفيه
الجمع بين الأدلة. أما الخوارج والمعتزلة فأخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص
الوعد، وأما المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، لكن أهل
السنة والجماعة أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد، وجمعوا بينها، وهذا
الحق (والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) [آل عمران:7]
فيردون هذا إلى هذا، ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر كما هو مذهب
أهل الزيغ (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه) [آل عمران:7]
يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم الذي يفسر المتشابه.
وقول المصنف: (مسلمين مؤمنين) ليس على إطلاقه؛ لأنهم قد يكونون ناقصين في
الإسلام والإيمان، ومتوعدين من الله عز وجل.
(125) ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما
قاله وأخبر مصدّقين:
أما لو جحدوا شيئاً مما جاء به النبي صلى لله عليه وسلم ولم يعترفوا،
صاروا كفاراً، ولو آمنوا ببعض ما جاء به، فإن جحدوا بعضه فهم كافرون
بجميع ما جاء به، فالواجب الإيمان به كله، سواء وافق أهواءنا أو خالفها؛
لأنه حق.
أما من كذب ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافر، فلو رد حديثاً في البخاري،
والحديث صحيح، وقال: أنا لا أومن بهذا الحديث ولا أصدقه؛ لأنه يخالف
العلم الحديث، فسبحان الله! كلام النبي صلى الله عليه وسلم يُتهم، وكلام
البشر لا يتهم؟ أيضاً العلم الحديث قد لا يخالف الأحاديث الصحيحة، والحمد
لله، فمثلاً ورد في حديث الذباب الذي ينكره هؤلاء أن في أحد جناحيه داءً
وفي الآخر دواءً، والطب يقر بهذا أن السم يعالج بضده، وبما يناقضه،
والذباب فيه النقيضان، فإنه إذا وقع في الماء فإنه يرفع الجناح الذي فيه
الدواء، ويغمس الجناح الذي فيه السم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر
بغمسه بجناحه الذي فيه الدواء( )، فيغالب السم، فهذا يقره الطب ولا يرده،
ولكنه لما خالف أذواق هؤلاء الجهال صاروا يتكلمون بهذا الكلام، وهذا كفر
والعياذ بالله، ولهم مقالات شنيعة نحو السنة، يردونها ويشككون فيها،
ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" ( )،
يقولون هذا وهم يدعون أنهم دعاة للإسلام، وهذا موقفهم من سنة النبي صلى
الله عليه وسلم، فهؤلاء الجهال يقولون: هذه من أمور الدنيا، والنبي عليه
الصلاة والسلام يقول: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" فمعناه: أنهم يُجهِّلون
النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (معترفين) (مصدقين) لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب
المرجئة، بل لابد مع ذلك من العمل بما جاء به، ولابد من الإخلاص في ذلك.
(126) ولا نخوض في الله، ولا نماري في دين الله:
لا نخوض في الله، بل نؤمن به وبصفاته وأسمائه، ولا نؤولها ونصرفها عن
ظاهرها، ونأتي بمعانٍ ما أرادها الله ولا أرادها النبي صلى الله عليه
وسلم، اتباعاً لأهوائنا وعقولنا القاصرة، وهذا كفر بالله عز وجل.
وكذلك في دين الله لا نماري –أي نجادل- ونقول: هذا نؤمن به وهذا نتوقف في
الإيمان به، فما دام ثبت في الكتاب والسنة فليس فيه مجال للخوض، بل نؤمن
به ونُسَلّم، وإن كان في عقولنا ما لا يدرك هذا الشيء، فعقولنا قاصرة،
ولو كانت كاملة لما احتاجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما احتاجت
البشرية إلى الرسل، فدل على أن العقول قاصرة، وأنه لابد من إرسال الرسل؛
لإحقاق الحق وإبطال الباطل.
(127) ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين:
قوله: (لا نجادل في القرآن) يشمل عدم القول بأنه ليس من عند الله، كما
يقوله الكفار، ويقولون: هو من عند محمد صلى الله عليه وسلم .
وكذلك الجدال في تفسير معاني القرآن، فلا نفسر القرآن من عند أنفسنا،
فالقرآن لا يفسر إلا بما جاء في كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم، أو ما قاله الصحابة أو ما قاله التابعون، أو ما
اقتضته اللغة العربية التي نزل بها.
فلا نقول فيه بعقولنا القاصرة، إنما يفسره الله سبحانه الذي نزله، أو
النبي عليه الصلاة والسلام الذي وُكل إليه بيانه، أو الصحابة الذين
تتلمذوا على المصطفى عليه الصلاة والسلام، أو التابعون الذين رووا عن
تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، أو اللغة التي نزل بها؛ لأنه نزل بلسان
عربي مبين. أما تفسيره بما يقوله الطبيب الفلاني أو المفكر الفلاني أو
الفلكي الفلاني، فالنظريات تختلف، فاليوم نظرية وغداً نظرية تبطلها؛
لأنها من عمل البشر، فلا يُفسَّر كلام الله بهذه الأشياء التي تتبدل
وتتغير كما يفعله الجهال اليوم ويقولون: هذا من الإعجاز العلمي.
قوله: (ونشهد أنه كلام رب العالمين) نشهد أن القرآن كلام الله تكلم الله
به حقيقة، وسمعه جبريل من الله، وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
وبلغه محمد عليه الصلاة والسلام إلى أمته، وبلغته أمته كل جيل إلى الجيل
الذي بعده، نحن نكتبه ونقرؤه ونحفظه، وهو بذلك كلام الله ما هو بكلامنا،
ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كلام جبريل عليه السلام.
(128) نزل به الروح الأمين، فعلّمه سيد المرسلين محمداً صلى الله عليه
وعلى آله وسلم:
الروح الأمين هو جبريل، وسمي بهذا لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل؛ مؤتمن
على ما حمله الله، لا يتهم بالخيانة كما تقوله اليهود يقولون: جبريل
عدونا. أو كما يقوله غلاة الشيعة: إن الرسالة لعلي ولكن جبريل خان وبلغها
إلى محمد صلى الله عليه وسلم . فهذا تكذيب لله؛ لأن الله سماه أميناً.
فأنزل الله في اليهود: (من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن
الله مصدقاً لما بين يديه) [البقرة:97]، ثم قال: (من كان عدواً لله
وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين) [البقرة: 98].
من عادى جبريل، أو ملكاً من الملائكة، فإن الله عدوه وكذا من عادى رسولاً
من الرسل، فهو كافر، ومن عادى ولياً من أولياء الله فإنه مبارز الله
بالمحاربة، كما صح في الحديث( )، فجبريل علّمه للنبي صلى الله عليه وسلم،
قال تعالى: (علمه شديد القوى) [النجم:5] وضمير المفعول في (علمه) راجع
إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشديد القوى: جبريل عليه الصلاة والسلام،
فعلّم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله.
(129) وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين:
هو كلام الله، تكلم به سبحانه حقيقة، وسمعه جبريل من الله حقيقة، وبلغه
إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان (لا يأتيه الباطل
من بين يديه ولا من خلفه) [فصلت:42]، (وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا
إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً*ولولا أن ثبتناك لقد كدت
تركن إليهم شيئاً قليلاً*إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد
لك علينا نصيراً) [الإسراء:73،75] فالرسول يبلغ القرآن، لا ينقص ولا يزيد
ولا يبدل (ولو تقول علينا بعض الأقاويل*لأخذنا منه باليمين*ثم لقطعنا منه
الوتين) [الحاقة:44،46].
وهو كلام الله، سبحانه وتعالى كما نزل، فالله حفظه من الزيادة والنقص:
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر:9]
(130) ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين:
لا نقول: القرآن مخلوق، كما تقول الجهمية، فهذا كفر وجحود لكلام الله،
ووصف لله بالنقص وأنه لا يتكلم، والذي لا يتكلم يكون ناقصاً ولا يكون
إلهاً.
ولهذا لما قال قوم السامري: هذا إلهكم وإله موسى، يعنون العجل أو
التمثال، قال الله جل وعلا: (أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك
لهم ضراً ولا نفعاً) [طه:89] فقال: (ألا يرجع إليهم قولاً) أي : لا
يتكلم، فدل على بطلان عبادتهم له.
وفي الآية الأخرى: (ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً)
[الأعراف:148] والكلام صفة كمال، وعدم الكلام صفة نقص، فالله سبحانه
وتعالى منـزه عن صفات النقص، ومتصف بصفات الكمال.
(ولا نخالف جماعة المسلمين) فجماعة المسلمين يؤمنون بأنه منـزل حقيقة غير
مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذه عقيدة المسلمين في القرآن.
وكذلك لا نخالف جماعة المسلمين في كل ما اجتمعوا عليه من أمور الدين. قال
تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً).
(من الله بدأ) وليس كما يقول بعض الضلال: إن جبريل أخذه من اللوح
المحفوظ، بل سمعه من الله مباشرة، (وإليه يعود) أي: في آخر الزمان، يرفع
القرآن إلى الله عز وجل، وهذا من علامات الساعة، فيُنـزع القرآن من
المصاحف وصدور الرجال، فلا يبقى في الأرض.
(131) ولا نكفَّر أحداً من أهل القبلة بذنب، ما لم يستحله:
(ولا نكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) هذا كما سبق أن الذنب
إذا لم يكن كفراً أو شركاً مخرجاً من الملة، فإننا لا نُكَفّر به المسلم،
بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الإيمان، معرض للوعيد وتحت المشيئة. هذه عقيدة
المسلم، ما لم يستحله، فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفر، كما لو استحل
الربا أو الخمر أو الميتة أولحم الخنـزير أو الزنا، إذا استحل ما حرم
الله كفر بالله، وكذلك العكس: لو حرم ما أحل الله كفر: (اتخذوا أحبارهم
ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم) [التوبة:31] وجاء تفسير
الآية بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم( ).
أما لو فعل الذنب وهو لم يستحله بل يعترف أنه حرام فهذا لا يكفر ولو كان
الذنب كبيرة دون الشرك والكفر لكنه يكون مؤمناً ناقص الإيمان أو فاسقاً
بكبيرته مؤمن بإيمانه.
وقوله: (لا نكفر بذنب) ليس على إطلاقه، فتارك الصلاة متعمداً يكفر( )،
كما دل على ذلك الكتاب والسنة.
(132) ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله:
كما تقوله المرجئة، يقولون: ما دام مصدقاً بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان،
أما الأعمال فأمرها هيّن، فالذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا
يعمل شيئاً من أعمال الطاعة، يقولون: هو مؤمن بمجرد ما في قلبه! وهذا من
أعظم الضلال.
فالرد عليهم أن الذنوب تضر على كل حال، منها ما يزيل الإيمان بالكلية،
ومنها ما لا يزيله بالكلية بل ينقصه وصاحبها معرض للوعيد المرتب عليها.
(133) ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته،
ولا نأمن عليهم، ولا نشهد لهم بالجنة:
هذا بحث للشهادة لمعين أنه من أهل الجنة، أو أنه من أهل النار، نحن لا
نشهد لأحد بجنة أو نار إلا بدليل، إلا من شهد له المصطفى عليه الصلاة
والسلام أنه من أهل الجنة، شهدنا له بذلك، ومن شهد له النبي صلى الله
عليه وسلم بالنار شهدنا له بذلك، هذا بالنسبة إلى المعينين، أما بالنسبة
إلى العموم فنعتقد أن الكافرين في النار، وأن المؤمنين في الجنة.
أما على وجه الخصوص فلا نحكم لأحد إلا بالدليل، لكن نرجو للمحسن ونخاف
على المسيء. هذه عقيدة المسلمين.
(134) ونستغفر لمسيئهم، ونخاف عليهم، ولا نُقَنِّطُهُم:
نستغفر للمسيء؛ لأنه أخونا، وندعو له بالتوبة والتوفيق؛ وإن كان مذنباً،
وهذا حق الإيمان علينا (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) [محمد:19].
ولا نُقنّطُ المذنب من رحمة الله كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لا نقنطه
من رحمة الله، بل هو معرض للوعيد وتحت المشيئة، وإن تاب تاب الله عليه عز
وجل: (إنه لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف:87] (ومن يقنط
من رحمة ربه إلا الضالون) [الحجر:56] (ياعبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا
تقنطوا من رحمة الله) [الزمر: 53].
والوعيدية الذين هم الخوارج ومن سار في ركابهم، هم الذين يُقنّطون الناس
من رحمة الله، ويخرجونهم من الملة بذنوبهم، وإن كانت دون الشرك.
(135) والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام:
من أصول العقيدة الإسلامية: الخوف والرجاء، وهما من أعظم أصول العقيدة،
والخوف والرجاء لابد من الجمع بينهما، لا يكفي الاقتصار على واحد منهما
فقط، كما قال تعالى في وصف أنبيائه: (إنهم كانوا يسارعون في الخيرات
ويدعوننا رغباً ورهباً) [الأنبياء:90].
رغباً: هذا هو الرجاء، ورهباً: هذا هو الخوف، وقال سبحانه وتعالى: (أولئك
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون
عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً) [الإسراء:57] فهم يجمعون بين الخوف
والرجاء.
وقال جل وعلا: (أمن هو قانت ءانآء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة
ويرجوا رحمة ربه) [الزمر:9]. ولابد معهما من المحبة لله، فلابد من هذه
الأمور الثلاثة: المحبة لله، والخوف منه سبحانه وتعالى، والرجاء لفضله.
فمن اقتصر على المحبة فقط فهو صوفي، فالصوفية يعبدون الله عز وجل
بالمحبة، ولا يخافون ولا يرجون، يقول قائلهم؛ أنا لا أعبده طمعاً في
جنته، ولا خوفاً من ناره، وإنما أعبده للمحبة فقط، وهذا ضلال والعياذ
بالله.
ومن عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج؛ لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف
والوعيد فقط، فكفروا بالمعاصي.
ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو من المرجئة، الذين أخذوا جانب الرجاء فقط،
وتركوا جانب الخوف.
أما أهل التوحيد فيعبدون الله بجميع الثلاث: بالحب والخوف والرجاء، ثم إن
الخوف لا يكون معه قنوط، فإن كان معه قنوط من رحمة الله صار كفراً (إنه
لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف:87] قال الخليل عليه
الصلاة والسلام: (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) [الحجر:56].
وكذلك الرجاء لا يكون رجاء مع الأمن من مكر الله وعدم الخوف، وهذا مذهب
المرجئة، وهو مذهب ضال (أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم
الخاسرون) [الأعراف:99] فالرجاء فقط كفر، والخوف دون الرجاء كفر، ولذلك
قال المصنف: ينقلان عن ملة الإسلام.
لذا يقول بعض السلف: يجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء؛ يعني:
يسوي بينهما، كجناحي الطائر، وجناحا الطائر معتدلان، لو اختل واحد منهما
سقط، فكذلك العبد بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر.
(136) وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة:
(الحق بينهما) أي: الخوف والرجاء (لأهل القبلة) أي : المسلمين، سُمُّوا
أهل القبلة؛ لأنهم يصلون إلى الكعبة، أما من لا يصلي إلى الكعبة فليس من
المسلمين لأن الله أمر بالتوجه إلى الكعبة، فالواجب اتباع أمره سبحانه
حينما نسخ الاستقبال لبيت المقدس، فالمؤمن يدور مع الأوامر؛ لأنه عبد لله
(وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب
على عقبيه) [البقرة:143].
(137) ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه :
هذا الكلام فيه مؤاخذة؛ لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة، ونواقض
الإسلام كثيرة منها: الجحود، ومنها: الشرك بالله عز وجل، ومنها:
الاستهزاء بالدين أو بشيء منه ولو لم يجحد، وهي نواقض كثيرة ذكرها
العلماء والفقهاء في أبواب الردة، ومنها: تحليل الحرام وتحريم الحلال.
وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منها عشرة، وهي أهمها، وإلا
فالنواقض كثيرة. فقصرُ نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط. وبعض الكتّاب
المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من أجل أن يصير الناس في سعة
من الدين، ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلم، إذا سجد للصنم وقال: أنا
ما جحدت، وأنا معترف بالتوحيد، إنما هو ذنب من الذنوب. أو ذبح لغير الله
أو سب الله أو سب الرسول أو سب الدين، يقولون: هذا مسلم لأنه؛ لم يجحد،
وهذا غلط كبير، وهذا يضيع الدين تماماً، فلا يبقى دين فالواجب الحذر من
هذا الخطر العظيم.
(138) والإيمان: هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان:
هذا تعريف المرجئة، قصروا الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان.
فالقول الحق: أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح،
فالأعمال داخلة في حقيقة الإيمان، وليست بشيء زائد عن الإيمان، فمن اقتصر
على القول باللسان والتصديق بالقلب دون العمل، فليس من أهل الإيمان
الصحيح.
فالإيمان –كما قال العلماء- : قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح،
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.
قال تعالى : (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون)
[الأنفال:2] وقال: (فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً) [التوبة:124]
وقال: (ويزداد الذين آمنوا إيماناً) [المدثر: 31] هذه الآيات تدل على
زيادة الإيمان والنقص، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: "من رأى منكم
منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك
أضعف الإيمان"( ) فدل على أن الإيمان ينقص. وفي رواية: "وليس وراء ذلك من
الإيمان حبة خردل"( ) دل على أن الإيمان ينقص، حتى يكون على وزن حبة
خردل.
وكما في الحديث الصحيح: "أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال
حبة من خردل من إيمان"( ).
فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص
بالعصيان، هذا تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة.
فليس كما تقوله الحنفية: قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط.
وليس كما تقوله الكرامية: قول باللسان فقط.
وليس كما تقوله الأشاعرة: اعتقاد القلب فقط.
وليس كما تقوله الجهمية: هو المعرفة بالقلب فقط.
فالمرجئة أربع طوائف، أبعدها الجهمية، وعلى قولهم يكون فرعون مؤمناً؛
لأنه عارف، وإبليس يكون مؤمناً؛ لأنه عارف بقلبه.
وعلى قول الأشاعرة: إنه التصديق بالقلب، يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل
وسائر المشركين يكونون مؤمنين؛ لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقون، يصدقون
النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه
صلى الله عليه وسلم .
واليهود يعترفون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولكن الحسد
والكبر: (الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم)
[البقرة:146]، وقال في المشركين: (قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم
لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) [الأنعام:33]، فمعنى (لا
يكذبونك) أي أنهم يصدقونك.
وأبو طالب يقول:
ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا
لولا الملامة أو حذار مسبةٍ لرأيتني سمحاً بذاك مبينا
(139) وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله
حق:
هذا كلام طيب، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، بخلاف
من يقولون: إن ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى متواتر
وآحاد، فلا يأخذون إلا بالمتواتر، ويقولون: أحاديث الآحاد تفيد العلم،
ولا تفيد اليقين، ولا يستدل بها في العقيدة، وهذا باطل، فكل ما صح عن
النبي صلى الله عليه وسلم –متواتراً أو آحاداً، فإنه يفيد العلم، وتبنى
عليه العقيدة؛ لأنه صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: (وما
آتاكم الرسول فخذوه…) [الحشر:7].
فإذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمل به في كل شيء، بشرط أن
يكون قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك طوائف الآن يشككون في
السنة؛ منهم من يقول: لا يجوز العمل بالسنة مطلقاً، ويكفي العمل بالقرآن
فقط( )، وهناك من يقول: يؤخذ من السنة المتواتر فقط، وكلا الطائفتين ضال.
فالواجب على المسلم أن يعتقد أن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم
فهو حق، والرسول صلى الله عليه وسلم عمل بخبر الواحد في وقائع كثيرة؛
رؤية الهلال؛ جاءه ابن عمر وأخبره بأنه رأى الهلال فأمر الناس بالصيام،
وجاءه أعرابي وأخبره أنه رأى الهلال فقال له: "أتشهد أن لا إله إلا الله؟
أتشهد أن محمداً رسول الله؟" قال: نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
الناس بالصيام( )، وهو خبر واحد.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحاداً، وما كان يرسل جماعات،
والمرسل إليهم يعملون بما بلغهم المندوب عن الرسول صلى الله عليه وسلم .
(140) والإيمان واحد. وأهله فيه سواء :
هذا غلط؛ لأن الإيمان ليس واحداً، وليس أهله سواء، بل الإيمان يتفاضل،
ويزيد وينقص، إلا عند المرجئة.
والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواءً، فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان
الفاسق من المسلمين؛ لأن الفاسق من المسلمين إيمانه ضعيف جداً، وإيمان
أبي بكر الصديق يعدل إيمان الأمة كلها( )، فليس الناس في أصله سواءً. هذا
من ناحية أصله.
كذلك من ناحية العمل، الناس يتفاضلون في العمل، منهم كما قال الله عز
وجل: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه)
[فاطر:32] هذا العاصي الذي معصيته دون الشرك، فإنه ظالم لنفسه؛ لأنه معرض
نفس للخطر (ومنهم مقتصد) وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات.
(ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله) [فاطر:32] وهذا هو الذي يعمل الواجبات
والمستحبات، ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط.
فالأمة ليست سواء، فصارت ثلاث طوائف، فمنها الظالم لنفسه، ومنها المقتصد،
ومنها السابق بالخيرات، فدل على أن الإيمان متفاضل.
(141) والتفاضل بينهم بالخشية والتقى، ومخالفة الهوى، وملازمة الأولى:
هذا لا يكفي لأن معناه إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، وأنه إذا صدق
بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان، والناس لا يتفاضلون في ذلك.
وهذا خطأ كبير؛ لأن التفاضل يحصل بما ذكره وبالأعمال الصالحة.
(142) والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم
للقرآن:
هذا حق، فالمؤمنون كلهم أولياء الله، يعني: أحبابه، فالله يحب المؤمنين
ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، كما أنه يبغض
الكافرين ويبغض الفاسقين، فالله يحب ويبغض على الأعمال.
فكل مؤمن يكون ولياً لله، وتتفاضل الولاية، بعضهم أفضل من بعض، قال جل
وعلا: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون* الذين آمنوا
وكانوا يتقون) [يونس:62،63] فمن الناس من ولايته مع الله تامة، ومنهم من
ولايته مع الله ناقصة، ومنهم من هو عدو لله بعيد عن الله سبحانه وتعالى.
فكل من فيه إيمان وتقوى فهو ولي الله، ولكن الولاية تتفاضل بحسب الأعمال،
فمنهم من ولايته كاملة، ومنهم من هو ولي من وجه، وهو المؤمن الفاسق، ولي
لله بطاعته، عدو لله بمعصيته ومخالفته.
ومنهم من هو عدو خالص كالكافر والمشرك.
هذا هو الحق، أما من يرى أنه ليس لله ولي إلا من بُنيَ على قبره مشهد أو
ضريح، والذي ليس عليه ضريح هذا فليس بولي؟ كما عند القبوريين! فهذا باطل.
(143) والإيمان: هو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم
الآخر، والقدر: خيره وشره، وحلوه ومره، من الله تعالى:
تعريف الإيمان هو كما سبق: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح،
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان( )، وأما ما ذكره المصنف هنا فهي أركانه كما
بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل "قال: أخبرني عن الإيمان،
قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن
بالقدر خيره وشره"( ) .
وله خصال كثيرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : "الإيمان بضع وسبعون
شعبة –أو بضع وستون شعبة- أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة
الأذى عن الطريق"( ) لكن هذه الستة هي الأركان والدعائم التي يقوم عليها.
وتقدم الكلام عن الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل،
والإيمان بالكتب، تقدم كل هذا، ولكنه متفرق في أول هذه العقيدة.
(144) ونحن مؤمنون بذلك كله:
يجب الإيمان بهذا كله، فإن جحد شيئاً من هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن؛
لأنه نقص ركناً من أركان الإيمان.
(145)لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به:
هذا سبق، أنه يجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله
منهم في القرآن ولم يسمَّ؛ فنؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى
عباده، فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض فهو كافر بالجميع؛ لو جحد نبياً واحداً
فإنه يكون كافراً بجميع الأنبياء (إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون
أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن
يتخذوا بين ذلك سبيلاً* أولئك هم الكافرون حقاً) [النساء:150،151].
فاليهود كفار؛ لأنهم كفروا بنبيين كريمين، كفروا بعيسى عليه الصلاة
والسلام، وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفار؛ لأنهم جحدوا
رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالذين يقولون اليوم: اليهود
والنصارى مسلمون ومؤمنون، وأنهم أهل أديان، ويجب التقارب بين الأديان
والحوار بين الأديان، هذا خلط وضلال والعياذ بالله، خلط بين الحق
والباطل، والإيمان والكفر لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ليس
هناك دين صحيح إلا الإسلام (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو
في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران:85].
فالإسلام نسخ كل ما قبله، وأمر الإنس والجن واليهود والنصارى والأميين
وجميع العرب والعجم، أمروا باتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا إيمان
إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم.
(146) وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا
يخلدون، إذا ماتوا وهم موحدون:
الكبائر هي الذنوب التي دون الشرك وفوق الصغائر، وضابط الكبيرة هو: كل
ذنب رُتب عليه حد، أو ختم بغضب أو لعنة أو نار، أو تبرى الرسول صلى الله
عليه وسلم من فاعله، فإن هذا كبيرة، كقوله: "من غشنا فليس منا" ( )، "من
حمل علينا السلاح فليس منا"( ).
كل هذه الاعتبارات تدل على أن الذنب كبيرة، ولكنها دون الشرك، فصاحبها لا
يخرج من الإيمان، وإنما يكون مؤمناً ناقص الإيمان، أو يسمى فاسقاً، هذا
مذهب أهل السنة والجماعة، لا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ولكن لا
يمنحون صاحبها اسم الإيمان المطلق، ولكن يمنحونه إيماناً مقيداً؛ فيقال:
مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته.
فلا يقال: هو مؤمن كامل الإيمان، كما تقوله المرجئة، ولا يقال: هو خارج
من الإسلام، كما تقوله الخوارج والمعتزلة.
إذاً: فالناس في صاحب الكبيرة التي هي دون الشرك ثلاث طوائف :
الخوارج والمعتزلة: أخرجوه من الإسلام، لكن الخوارج أدخلوه في الكفر،
والمعتزلة لم يدخلوه، وقالوا: هو في منـزلة بين المنـزلتين، ولكنهم
أخرجوه من الإسلام.
المرجئة قالوا: هو مؤمن كامل الإيمان، طالما أنه يعتقد في قلبه الإيمان
عند جمهورهم وينطق بلسانه عند بعضهم، فإنه مؤمن كامل الإيمان، ولا تنقص
هذه المعاصي من إيمانه، وإن كانت كبائر، وهذا ضلال أيضاً.
أما القول الحق فهو مذهب أهل السنة والجماعة: أن صاحب الكبيرة دون الشرك
مؤمن، وليس بكافر، لكنه ناقص الإيمان. فهذا يجب معرفته، ويجب أن ترسخه في
عقلك، فأهل الشر زاد شرهم في هذا الوقت، وصاروا يظهرون مذهب الإرجاء
ليروجوه على الناس، وليستروا على أنفسهم ما هم فيه من الضلال.
فهذا معرفته من أوجب الواجبات على طالب العلم اليوم.
(147) وإن لم يكونوا تائبين، بعد أن لقوا الله عارفين "مؤمنين" وهم في
مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه:
(ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) وإن شاء عذبهم في النار بعدله:
نعم، هذا هو المذهب الحق: أن أصحاب الكبائر التي دون الشرك ليسوا كفاراً،
وأنهم إذا لقوا الله ولم يتوبوا من هذه الكبائر فإنهم تحت المشيئة، إن
شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بتوحيدهم
وإيمانهم، لا يخلدون في النار، والدليل على ذلك قوله تعالى: (إن الله لا
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء:48]، لكن قوله:
(عارفين مؤمنين) فيه إجمال، فلو قال: (موحدين) كما قال أولاً لكان أحسن.
وإن شاء الله أمضى فيهم الوعيد، ولكنهم لا يخلدون في النار، هذا مذهب أهل
السنة والجماعة، وهذا هو المذهب الحق، بخلاف الخوارج الذين يقولون: إنهم
في النار على أي حال، وإنهم خالدون فيها، فمن دخل النار عندهم لا يخرج
منها. وخلاف المرجئة القائلين: إنهم لا يمرون على النار أبداً، فهذا غلط،
بل لا نضمن لهم النجاة، فهم تحت المشيئة.
إن شاء عفا عنهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله، وما ظلمهم الله سبحانه
وتعالى، بل عذبهم بأعمالهم التي أوجبت لهم ذلك، فالله لا يعذب من لم
يعصه، ولا يساوي بين العاصي وبين المؤمن المستقيم، (أفنجعل المسلمين
كالمجرمين*ما لكم كيف تحكمون) [القلم: 35،36] (أم نجعل الذين آمنوا
وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) [ص:28].
هذا استنكار من الله عز وجل، (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون)
[الجاثية: 21].
(148) ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته:
كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن عصاة الموحدين
يخرجون من النار( )، إما بفضل الله تعالى، وإما بشفاعة الشافعين بإذن
الله تعالى، والشفاعة حق، ولكن لا تكون إلا بإذن الله، وأن يكون المشفوع
فيه من أهل التوحيد، لا من الكافرين ولا من المشركين ولا من المنافقين.
(149) ثم يبعثهم إلى جنته:
بعد إخراجهم من النار، ورد أنهم يخرجون من النار كالفحم محترقين، ثم
يلقون في نهر يسمى: نهر الحياة، فتنبت أجسامهم ولحومهم، ثم بعد ذلك إذا
هُذبوا ونُقوا أُذن لهم في دخول الجنة، فيدخلون في الجنة( ).
(150) وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل
نكرته، الذين خابوا من هدايته، ولم ينالوا من ولايته :
قال تعالى : (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا
وعملوا الصالحات) [الجاثية:21]، وقوله تعالى: (أم نجعل المتقين كالفجار)
[ص:28] إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله لا يسوي بين أهل
طاعته وأهل معصيته، ولا بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بل يجازي كلاً
بعمله. (ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم
ينالوا من ولايته) بل ميز بينهم سبحانه في الدنيا وفي الآخرة، ميز بين
أهل الطاعة والمعصية، وبين أهل الكفر والإيمان، في الدنيا وفي الآخرة،
ميز بينهم في الدنيا في صفاتهم وعلاماتهم وأفعالهم، فليست أفعال أولياء
الله وأهل الطاعة مثل أفعال أعدائه ولا أقوالهم ولا تصرفاتهم، انظر إلى
الناس الآن، وانظر إلى تصرفاتهم، انظر إلى تصرفات المتقين والمؤمنين،
وانظر إلى تصرفات الفسقة والعاصين، وانظر إلى تصرفات الكفار والملحدين،
هذا في الدنيا.
وفي الآخرة كذلك يميز الله بينهم، فهؤلاء يكرمهم بجنته، وهؤلاء يعذبهم
بناره وعقوبته؛ لأنه سبحانه حكيم يضع الأمور في مواضعها، فلا يضع الرحمة
إلا فيمن يستحقها، ولا يضع سبحانه وتعالى العذاب إلا فيمن يستحقه. لكن
قوله: (أهل معرفته) فيه قصور وإيهام أن الإيمان هو مجرد المعرفة كما
يقوله غلاة المرجئة فلو قال: (أهل طاعته) لكان أحسن وأوضح.
(151) اللهم يا وليّ الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به:
هذا من أجمل كلام المصنف يرحمه الله!
إنه لما ذكر هذه المسائل العظيمة الخطيرة سأل الله التثبيت، ألا يضله
الله مع أصحاب هذه الضلالات وأصحاب هذه المقالات الضالة، فهذا من الفقه
والحكمة؛ أن الإنسان لا يغتر بعلمه، ويقول: أنا أعرف التوحيد وأعرف
العقيدة، وليس عليّ خطر، هذا غرور بل عليه أن يخاف من سوء الخاتمة
والضلال، يخاف أن ينخدع بأهل الضلال، كم من معتدل انحرف، خصوصاً إذا
اشتدت الفتن، يصبح الرجل مسلماً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً ويصبح
كافراً، ويبيع دينه بعرض من الدنيا، كما صح الحديث بذلك( ).
الفتن إذا جاءت يسأل الإنسان الله الثبات( )، ولا يقول: أنا لست على خطر،
أنا عارف وأنا أصلي، نعم، أنت عارف وتصلي والحمد لله، لكن عليك خطر وعليك
أن تخاف، أنت أفضل أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال: (واجنبني وبنيّ
أن نعبد الأصنام) [إبراهيم:35] إبراهيم خاف على نفسه من عبادة الأصنام،
مع أنه هو الذي كسّرها وحطّمها بيده، ولقي في ذلك العذاب والإهانة في
سبيل الله عز وجل، ومع هذا يقول: (وأجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام)[إبرهيم:35]
ولم يقل: أنا الآن نجوت، بل طلب من الله أن يجنبه وبنيه أن يعبدوا
الأصنام، فالإنسان يخاف دائماً من ربه عز وجل، وكم من مهتد ضل، وكم من
مستقيم انحرف، وكم من مؤمن كفر وارتد، وكم من ضال هداه الله، وكم من كافر
أسلم، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى.
(152) ونرى الصلاة خلف كل برٍّ وفاجرٍ من أهل القبلة، وعلى من مات منهم:
هذا فيه مسألتان:
الأولى: أن الصلاة عمل وإحسان، فإذا فعلها الناس خصوصاً ولاة الأمور،
فإنهم عملوا معروفاً وإحساناً، وفي ترك الصلاة خلفهم فيه محظور عظيم، من
شق العصا، وتفريق الكلمة، وسفك الدماء وهذا خطر عظيم، فيجب أن يُتلافى،
قال عليه الصلاة والسلام: "صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وعلى من
قال: لا إله إلا الله"( )، هذا من حيث العموم، فكيف بولاة الأمور الذين
في منابذتهم ومخالفتهم شق لعصا الطاعة، وتفريق الكلمة، وآثار سيئة على
المسلمين؟
هذا مذهب أهل السنة والجماعة، يصلون الجمع والجماعات، ويجاهدون في سبيل
الله مع كل أمير، براً كان أو فاجراً، ما لم يخرج عن الإسلام.
هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، من عهد الصحابة إلى عهد الأئمة، وهو
الذي عليه إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة.
المسألة الثانية: الصلاة على جنازة المسلم وإن كان فاسقاً، ما لم يخرج من
الإسلام، فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، أما إذا خرج عن
الإسلام فلا يصلى عليه؛ لأنه ليس بمسلم، وليس كل إنسان يَحكُمُ على الناس
بالردة، إنما يحكم بذلك أهل العلم والبصيرة بالرجوع إلى قواعد أهل السنة
والجماعة، أما كل أحد فلا يحكم بذلك، وإن كانت نيته طيبة ومقصده حسناً،
إنما الحكم لأهل البصيرة والراسخين في العلم.
(153) ولا ننـزل أحداً منهم جنة ولا ناراً:
نحن لا نشهد لأحد، مهما بلغ من الصلاح والتقى، لا نشهد له بالجنة؛ لأننا
لا نعلم الغيب، ولا نحكم لأحد من المسلمين بالنار مهما عمل من المعاصي،
لا نحكم عليه بالنار؛ لأننا لا ندري بما ختم له وما مات عليه( )، وهذا في
المعيّن.
فنحن ما لنا إلا الظاهر فقط، وكذلك لا يحكم لأحد بالنار، إلا من شهد له
بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء بجنة أو نار، مثل العشرة المبشرين
بالجنة، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد
بن عمرو بن نفيل، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة
عامر بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله، رضي الله عنهم( ). وكذلك شهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري، شهد له بالجنة،
وكذلك رجل من الأنصار قال: "يدخل عليكم رجل من أهل الجنة" فدخل رجل تنطف
لحيته من وضوئه، وبيده اليسرى نعلاه، ثم جلس في الحلقة، وفي اليوم الثاني
والثالث قال عليه الصلاة والسلام نفس المقالة، ودخل نفس الرجل، وهذا من
باب التأكيد، وإلا فشهادة واحدة تكفي، وقد تابعه عبد الله بن عمرو –رضي
الله عنهما- حتى يعلم عمله الذي بسببه بشر بالجنة، فلم يجد عنده كثير
عبادة، وجده محافظاً على الفرائض، ويقوم من الليل، وكان إذا استيقظ من
الليل ذكر الله وسبح وهلل، فلما أراد عبد الله أن يغادر قال للرجل: إني
سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا، فأردت أن أسبر عملك،
فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت. فلما ولىّ دعاه وقال: إلا أنني لا أجد في
قلبي غلاً على مسلم، قال: هذا، الذي لا نطيقه( ).
الحاصل: أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهد لأحد بالجنة، فإننا نشهد له
بالجنة، ونقطع له بالجنة، وأما غيره فلا نقطع له، ولكن نرجو له الخير.
وكذلك الكافر المعين لا نحكم عليه بالنار؛ لأنه قد يتوب ويموت على
التوبة، يختم له بخير، لكننا نخاف عليه، هذا من حيث التعيين.
أما من حيث العموم: فنقطع أن المسلمين في الجنة، ونقطع أن الكفار من أهل
النار.
(154) ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، ما لم يظهر منهم شيء من
ذلك:
الأصل في المسلم: العدالة، وهذه قاعدة عظيمة فلا نسيء الظن فيه ولا نتجسس
عليه، ولا نتتبعه، لكن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه، وإن لم يظهر شيء
فلا نسيء الظن بالمسلمين، فنعامله بما يظهر منه، ونحن لسنا مكلفين بالبحث
عن الناس والتحري عنهم والحكم عليهم، لم يكلفنا الله بذلك( ).
(155) ونذر سرائرهم إلى الله تعالى:
نحسن الظن بهم، وسرائرهم إلى الله تعالى، ولم نكلف أن نبحث عن الناس وعن
أحوالهم، والواجب ستر المسلم وإحسان الظن به، والتآخي بين المسلمين( )
(إنما المؤمنون إخوة) [الحجرات:10].
(156) ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب
عليه السيف :
لا يجوز قتل المسلم، واستباحة دمه؛ لأن الله عصمه بالإسلام، قال عليه
الصلاة والسلام: "أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله،
فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على
الله"( ) فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين، ولم يظهر منه ناقض من نواقض
الإسلام، فإن دمه حرام، فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمه، قال عليه
الصلاة والسلام: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"( ) قال هذا في خطبته بمنى يوم النحر.
هل هناك أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة؛ لأن
النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى الكعبة قال: "ما أشد حرمتك! وحرمة
المسلم أعظم عند الله من حرمتك" أو كما قال عليه الصلاة والسلام( ).
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:
الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"( ).
الأول: الثيب الزاني، هو المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح وهما
عاقلان بالغان حران، فإذا زنى رُجم حتى الموت.
الثاني: المسلم إذا تعدّى على المسلم فقتله ظلماً وعدواناً، وطالب أولياء
المقتول بالقصاص فيُقتل (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في
القتلى) [البقرة:178] أي : فرض عليكم، وقال تعالى : (وكتبنا عليهم فيها
أن النفس بالنفس) [المائدة:45].
والثالث : هو المرتد، فيقتل حد الردة، وما عدا الثلاثة فدم المسلم محرَّم
حرمةً عظيمة.
كذلك البغي، إن بغى على المسلمين ولو كان مسلماً فالبغاة يقاتلون؛ لأنهم
يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين، ويخرجوا على إمامهم، فيجب قتالهم (وإن
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى
فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله) [الحجرات:9] وتُستحل دماؤهم من
أجل كفهم عن البغي، ولصيانة جماعة المسلمين وكلمتهم وحفظ الأمن.
وكذلك تستباح دماء قطاع الطريق (إنما جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله
ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من
خلاف أو ينفوا من الأرض) [المائدة:33] فجزاؤهم على حسب جرائمهم .
فهؤلاء أحل الله قتلهم؛ لدفع شرهم وعدوانهم .
(157) ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا:
هذه مسألة عظيمة، فمن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم لا يرون الخروج على
ولاة أمر المسلمين (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
وأولي الأمر منكم) [النساء:59] وقال عليه الصلاة والسلام: "من يطع الأمير
فقد أطاعني، ومن يعصِ الأمير فقد عصاني"( ) فلا يجوز الخروج عليهم؛ ولو
كانوا فساقاً لأنهم انعقدت بيعتهم، وثبتت ولايتهم، وفي الخروج عليهم ولو
كانوا فساقاً مفاسد عظيمة، من شق العصا، واختلاف الكلمة، واختلال الأمن،
وتسلط الكفار على المسلمين.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت
حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج) أو كما ذكر.
وهذا حتى عند الكفار، إذا قاموا على ولي أمرهم وخرجوا عليه، فإنه يختل
أمنهم ويصبحون في قتل وقتيل، ولا يقر لهم قرار، كما هو مشاهد في الثورات
التي حدثت في التاريخ، فكيف بالخروج على إمام المسلمين؟ فلا يجوز الخروج
على الأئمة وإن كانوا فساقاً، ما لم يخرجوا عن الدين، قال عليه الصلاة
والسلام: "اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه
برهان"( ) فالفسق والمعاصي لا توجب الخروج عليهم، خلافاً للخوارج
والمعتزلة الذين يرون الخروج عليهم إن كان عندهم معاصٍ وحصل منهم فسق،
فيقولون: هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على
ولاة أمور المسلمين.
فأصول المعتزلة خمسة:
الأول: التوحيد، ومعناه: نفي الصفات، ويرون من يثبت الصفات فهو مشرك.
الثاني: العدل، ومعناه: نفي القدر، فيقولون: إن إثبات القدر جور وظلم،
ويجب العدل على الله.
الثالث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويريدون به الخروج على أئمة
المسلمين إن كان عندهم معاصٍ دون الكفر. وهذا هو المنكر بنفسه، وليس من
المعروف في شيء.
الرابع: المنـزلة بين المنـزلتين، وهو الحكم على أصحاب الكبائر بالخروج
من الإسلام، وعدم الدخول في الكفر، وأما الخوارج فيحكمون عليه بالكفر.
الخامس : إنفاذ الوعيد، ومعناه، أن من مات على معصية وهي كبيرة من
الكبائر دون الشرك، فهو خالد مخلد في النار، فهم يوافقون الخوارج في
مصيره في الآخرة، ويخالفون الخوارج في أنه في منـزلة بين المنـزلتين،
وألّف فيها القاضي عبد الجبار –من أئمتهم- كتاباً سماه: شرح الأصول
الخمسة.
(158) وإن جاروا:
الجور معناه: الظلم، وإن تعدوا وظلموا الناس بأخذ أموالهم، وضرب ظهورهم،
أو يقتلون المسلم، فلا يرون الخروج عليهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:
"اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك"( ) فالصبر عليهم أولى من الخروج؛ لما
في الخروج من المفاسد العظيمة، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع
أعلاهما، وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم
أمر بالصبر على جور الولاة وإن ظلموا وجاروا وإن فسقوا.
(159) ولا ندعو عليهم:
لا يجوز الدعاء عليهم: لأن هذا خروج معنوي، مثل الخروج عليهم بالسلاح،
وكونه دعا عليهم؛ لأنه لا يرى ولايتهم، فالواجب الدعاء لهم بالهدى
والصلاح، لا الدعاء عليهم، فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، فإذا
رأيت أحداُ يدعو على ولاة الأمور، فاعلم أنه ضال في عقيدته، وليس على
منهج السلف، وبعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله عز وجل،
لكنها غيرة وغضب في غير محلهما؛ لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد.
قال الإمام الفضيل بن عياض –رحمه الله- ويروي ذلك عن الإمام أحمد يقول:
(لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان).
والإمام أحمد صبر في المحنة، ولم يثبت عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم،
بل صبر وكانت العاقبة له، هذا مذهب أهل السنة والجماعة.
فالذين يدعون على ولاة أمور المسلمين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة،
وكذلك الذين لا يدعون لهم، وهذا علامة أن عندهم انحرافاً عن عقيدة أهل
السنة والجماعة.
وبعضهم ينكر على الذين يدعون في خطبة الجمعة لولاة الأمور، ويقولون: هذه
مداهنة، هذا نفاق، هذا تزلف. سبحان الله ! هذا مذهب أهل السنة والجماعة،
بل من السنة الدعاء لولاة الأمور؛ لأنهم إذا صلحوا صلح الناس، فأنت تدعو
لهم بالصلاح والهداية والخير، وإن كان عندهم شر، فهم ما داموا على
الإسلام فعندهم خير، فما داموا يُحَكِّمون الشرع، ويقيمون الحدود،
ويصونون الأمن، ويمنعون العدوان عن المسلمين، ويكفون الكفار عنهم، فهذا
خير عظيم، فيدعى لهم من أجل ذلك. وما عندهم من المعاصي والفسق، فهذا إثمه
عليهم، ولكن عندهم خير أعظم، ويُدعى لهم بالاستقامة والصلاح فهذا مذهب
أهل السنة والجماعة، أما مذهب أهل الضلال وأهل الجهل، فيرون هذا من
المداهنة والتـزلف، ولا يدعون لهم، بل يدعون عليهم.
والغيرة ليست في الدعاء عليهم، فإن كنت تريد الخير؛ فادعُ لهم بالصلاح
والخير، فالله قادر على هدايتهم وردهم إلى الحق، فأنت هل يئست من
هدايتهم؟ هذا قنوط من رحمة الله، وأيضاً الدعاء لهم من النصيحة، كما قال
عليه الصلاة والسلام: "الدين النصيحة، الدين النصيحة، الذين النصيحة"
قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين
وعامتهم"( ) . فهذا أصل عظيم يجب التنبه له، وبخاصة في هذه الأزمنة.
(160) ولا ننـزع يداً من طاعتهم :
(ولا ننـزع يداً من طاعتهم) هذا تأكيد لما سبق، حتى ولو حصل منهم ظلم
وجور ومعاصٍ وكبائر دون الشرك، فإننا لا ننـزع يداً من طاعتهم، ولا نخرج
عليهم ولا نعصيهم (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
الأمر منكم) [النساء:59] بل نجاهد معهم، ونشهد الجمع والجماعات والأعياد
معهم؛ من أجل اجتماع كلمة المسلمين.
(161) ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية:
قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
الأمر منكم) [النساء:59] فالله أمر بطاعة ولاة الأمر من المسلمين، أما
الكافر فلا طاعة له على المسلمين (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
سبيلاً) [النساء:141] لأنه قال: (وأولي الأمر منكم) يعني المسلمين. فتجب
طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله، فلا
تطعه في تلك المعصية، لكن ليس المعنى أن تخرج عليه وتنـزع الطاعة مطلقاً،
بل لا تطعه في تلك المعصية، وأطعه فيما عداها، مما ليس بمعصية وقال عليه
الصلاة والسلام: "إنما الطاعة في المعروف"( ).
(162) وندعو لهم بالصلاح والمعافاة:
ندعو الله أن يرجعهم إلى الحق، ويصحح ما عندهم من الخطأ، ندعو لهم
بالصلاح؛ لأن صلاحهم صلاح للمسلمين، وهدايتهم هداية للمسلمين، ونفعهم
يتعدّى لغيرهم، فأنت إن دعوت لهم دعوت للمسلمين.
(163) ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة:
هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو اتباع سنة النبي صلى الله
عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: "فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً
كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا
بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار"( ) فلما أمر بالسنة، نهى عن البدعة.
والبدعة: ما أُحدث في الدين مما ليس منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "من
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"( )، وكل عبادة وكل عمل يتقرب به العبد
لله، وليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة، فهو بدعة، وإن كان قصد فاعله
التقرب إلى الله فهو إنما يبعده عن الله، ولا يثاب عليه؛ بل يعاقب،
فالسنة ما كان عليه دليل من الكتاب أو السنة.
والبدع كثيرة جداً، فالناس يُحدثُون بدعاً كثيرة، فالبدع لا تُقرّ ولا
يُعمل بها مهما كانت وممن صدرت، ومن البدع ما يعمل من الاحتفالات بالمولد
النبوي، فهو بدعة، ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة ولا هدي الخلفاء
الراشدين، ولا من هدي القرون المفضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله
عليه وسلم بالخيرية، إنما أُحدث بعد هذه القرون لما فشا الجهل، وأول من
أحدث المولد: الشيعة الفاطميون، ثم أخذه الأغرار المنتسبون لأهل السنة عن
حسن نية وقصد، ويزعمون أنه من محبة الرسول، وليس ذلك من محبته، إنما
المحبة بالاتباع لا الابتداع:
تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيــع
فعلامة المحبة الصادقة: الاتباع، أما الابتداع فهي علامة على الكراهة؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدعة، وأنت تحييها وتحدثها، فمعنى
ذلك أنك تكره السنة، وإذا كنت تكره السنة فأنت تكره الرسول فإن كنت تريد
الخير فتب إلى الله وارجع، أما العناد والمكابرة فهذا اختيار سيئ لنفسك.
وكذلك نلزم الجماعة ونترك الشذوذ؛ فلا نأتي بعمل ولا بقول شاذ ليس عليه
عمل المسلمين وقولهم؛ لأن هذا يُفرّق الكلمة ويحدث العداوة، فما دام
المسلمون يمشون على منهج الكتاب والسنة، فلا نترك ما هم عليه لقول شاذ،
فالشذوذ والمخالفات لا تجوز، والحمد لله، المسلمون يبحثون عن الحق،
وإجماعهم "إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة"( )، حتى الحديث إن ورد
عن طريق وسند صحيح، لكن فيه مخالفة لما هو أصح منه؛ فيسمى حديثاً شاذاً
عند المحدثين.
فيجب التثبت في هذه الأمور، ولا ننبش في أقوال وأفعال مهجورة ونؤلف فيها
ونشوش على الناس أمور دينهم، والشذوذ: مخالفة ما عليه جماعة المسلمين،
والخلاف ضد الاتفاق، والفرقة ضد الاجتماع، والشذوذ ضد الائتلاف، أما أن
نبحث عن الشاذ، فهذا تضليل للأئمة وتجهيل لهم، وهل أنت أوتيت علماً أكثر
من علمهم، وخصصت بعلم لم يصلوا إليه؟ وما آل إليه بعض الناس من هذه
الأمور في العصور المتأخرة التي يفشو فيها الجهل، وأغلب ما يصدر ذلك عن
واحد متعالم وليس بعالم، ولم يدرس العقيدة الصحيحة والفقه، إنما تفقه على
نفسه وصار يضيف إلى دين الله ما ليس منه، وهذه مصيبة، فالعلم ليس بفوضى،
إنه يحتاج إلى ضوابط وفقه ودراية.
(164) ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة:
المحبة عمل قلبي ، والمحبة على قسمين:
أولاً: محبة طبيعية، كمحبة الإنسان لأهله وزوجته وأولاده، ومحبته
لأصدقائه، ومحبته للأكل والشرب، فهذه المحبة لا تدخل في أمر العبادة.
ثانياً: محبة دينية، وهذه على نوعين:
النوع الأول: محبة الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم أنواع العبادة، يقول ابن
القيم:
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان
وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان
عبادة الرحمن غاية حبه، أي: منتهى حبه، وتدور عليها أمور العبادات كلها،
فهي نوع عظيم من أنواع العبادة، لا يجوز أن يُحب أحد مع الله (ومن الناس
من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله) [البقرة:165] هذا شرك في
المحبة، التي هي أعظم أنواع العبادة، ولذلك قال: (والذين آمنوا أشد حباً
لله) [البقرة:165] فالمؤمنون لا يحبون إلا الله، ومحبتهم أشد من محبة أهل
الأصنام لأصنامهم؛ لأن محبة الله لا تنقطع في الدنيا ولا في الآخرة، أما
محبة غيره من المعبودين فتنقطع في الآخرة، وتحصل العداوة بين من عبد من
دون الله ومن عبده (وإذا حُشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم
كافرين) [الأحقاف:6]، (إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في
الحياة والدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً
ومأواكم النار) [العنكبوت:25].
النوع الثاني: المحبة في الله ولأجل الله، وذلك بأن تحب ما يحبه الله من
الأعمال والأشخاص، وتحب أهل الإيمان والتقوى، (إن الله يحب التوابين ويحب
المتطهرين) [البقرة:222]، (إن الله يحب المحسنين) [البقر:195]، فأنت
تحبهم؛ لأن الله يحبهم، وفي مقدمة هؤلاء: الملائكة، والأنبياء والرسل،
والأولياء والصالحون، وجميع المؤمنين.
وهذه تسمى المحبة في الله، وهي أوثق عرى الإيمان، كما جاء في الحديث:
"أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله"( )، وقال عليه الصلاة
والسلام: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان" ذكر منها: "أن يحب المرء لا
يحبه إلا لله"( ).
فتحب أولياء الله لأن الله يحبهم، وتبغض أعداء الله لأن الله يبغضهم،
فيكون الحب والبغض من أجل الله، وليس طمعاً في الدنيا، فلا يجد العبد
حلاوة الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله، ويوالي ويعادي الله.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: "صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا،
وذلك لا يجدي على أهله شيئاً".
وهذه المحبة تبقى في الدنيا والآخرة، وأما محبة الدنيا فتنقطع، وتكون
عداوة في الآخرة (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) [الزخرف:67].
وتبغض الشخص من أجل الله، وليس من أجل أنه أساء إليك؛ بل تبغضه؛ لأنه عدو
لله، وهذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الحب والبغض في الله، (قد
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءؤا
منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة
والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) [الممتحنة:4].
ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله "رجلان تحابا في
الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه"( ) فالحب في الله والبغض في الله أمره
عظيم؛ لأنه فرقان بين الحق والباطل (يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله
يجعل لكم فرقاناً) [الأنفال:29]، فالمؤمن يكون عنده فرقان، يفرق بين هذا
وهذا.
وقد ذكر العلماء أن الناس في المحبة على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: منهم من يحب محبة خالصة ليس معها بغضاء، وهم الملائكة
والرسل عليه الصلاة والسلام، وخُلّص المؤمنين كالصحابة (ربنا اغفر لنا
ولإخوننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا)
[الحشر:10] وكذلك السلف الصالح وأهل السنة والجماعة؛ لصفاء ما هم عليه من
العقيدة وما هم عليه من الحق؛ لطاعتهم لله ورسوله.
القسم الثاني: من يبغض بغضاً خالصاً ليس معه محبة، وهم الكفار، أعداء
الله (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء) [الممتحنة:1]
أي : أحباء تحبونهم وتوالونهم وتناصرونهم، وتدافعون عنهم، بل الواجب
التبرؤ منهم؛ لأنهم أعداء الله (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر
يوادّون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أوأبناءهم أو إخوانهم أو
عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري
من تحتها الأنهار) [المجادلة: 22] والمقصود بالروح هنا: قوة الإيمان .
القسم الثالث: من يجتمع فيه محبة وبغض، وهو المؤمن العاصي، يحب من وجه،
ويبغض من وجه، تحبه لما فيه من الخير والطاعة، وتبغضه لما فيه من المعاصي
والمخالفة، هكذا ينبغي على المسلم أن يميز.
والمحبة بابها باب عظيم ينبغي التنبه له ومعرفته؛ لأن عليه مداراً عظيماً
في العقيدة وأمور الدين، فالإنسان لا يمشي إمعة، لا يدري من يحب ومن
يبغض، بل يجعل المحبة والبغضاء ميزاناً يفرق بين أولياء الله وأولياء
الشيطان، ولا يجعله ميزاناً دنيوياً وهوى، فمن وافقه على دنياه وهواه
وأعطاه شيئاً من الدنيا أحبه، ولو كان من أكفر الناس وأفسقهم، وإن لم
يعطه شيئاً أبغضه، ولو كان من أصلح الصالحين، فهذا لا يجوز.
(165) ونقول: الله أعلم، فيما اشتبه علينا علمه:
هذه مسألة عظيمة، وهي مسألة العلم فالإنسان لا يقول ما لا يعلم، إن علم
شيئاً قال به، وإن جهل شيئاً فلا يقول به، ولا يقول في أمور الدين
والعبادات ولا يدخل فيها بغير علم، بل يتوقف، ويقول: الله أعلم.
والإمام مالك إمام دار الهجرة، جاءه رجل فسأله عن أربعين مسألة، فأجاب عن
أربع منها، وقال في الباقي: لا أدري، فقال الرجل: أنا جئتك من كذا وكذا
على راحلتي وتقول: لا أدري؟ قال له الإمام: اركب راحلتك، وارجع إلى البلد
الذي جئت منه، وقل: سألت مالكاً فقال: لا أدري!!
والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء لم ينـزل عليه فيه وحي فإنه
ينتظر حتى ينـزل عليه وحي، كذلك الصحابة إذا سألهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن شيء لا يعلمونه قالوا: "الله ورسوله أعلم"، لا يتخرصون.
فهذا الباب عظيم وخطير، والله عز وجل جعل القول عليه بغير علم مرتبة فوق
الشرك به سبحانه وتعالى : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينـزل به سلطاناً وأن
تقولوا على الله ما لا تعلمون) [الأعراف:33]، وقال سبحانه: (ولا تقف ما
ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً)
[الإسراء:36].
يا أخي، يسعك أن تقول: لا أدري، ومن قال: لا أدري، فقد أجاب، ولا تتخرص
وتخوض في أحكام الشرع بغير بصيرة، وقول: لا أدري، فيما لا تعلم، ليس
نقصاً فيك، بل العكس، هو كمال؛ لأنه ورع وتقوى، والناس يحمدونك على هذا،
كثير من المنتسبين إلى العلم –وبخاصة في هذه الأزمنة المتأخرة التي قل
فيها الفقهاء وكثر القراء- يفتون ويحكمون ويتخبطون في الأحكام الشرعية في
وسائل الإعلام وغيرها بغير بصيرة، ومن فضل الله أنهم انكشفوا أمام الناس
بجهلهم، وفضحهم الله عز وجل، ولو أنهم ستروا أنفسهم وتوقفوا عما ليس لهم
به علم وتورّعوا؛ لكان ذلك أكمل وأجل لهم عند الله وعند الناس، فلنعتبر
بهذا.
(166) ونرى المسح على الخفين، في السفر والحضر، كما جاء في الأثر:
لماذا جاء بهذه المسألة –وهي مسألة فقهية- في العقيدة؟
لأن هذه المسألة أنكرها المبتدعة، وأثبتها أهل السنة، والمسح على الخفين
تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وممن اشتهر عنهم إنكار المسح على الخفين: الرافضة، ويخالفون أهل السنة
والجماعة في ذلك، ويخالفون الأحاديث الثابتة، فالمسح ثابت، يوم وليلة
للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهذه رخصة وتسهيل من الله على
عباده.
فالرافضة ينكرون المسح على الخفين، ويقولون بالمسح على الرجلين، وهذا من
أكبر المغالطة، فلا أحد يقول بالمسح على الرجلين، وهكذا من ترك الحق
ابتلاه الله بالباطل.
استدل الرافضة على المسح على الرجلين: بقوله تعالى: (وامسحوا برءوسكم
وأرجلكم) [المائدة:6] بقراءة الجر، حيث عطف الأرجل على الرؤوس في هذه
القراءة، والرؤوس ممسوحة، وعندهم الكعبان معقد الشراك، مجمع القدم مع
العقب ويسمى عرش الرِّجْل.
وعند أهل السنة والجماعة أن المراد بالكعبين: العظمان الناتئان في أسفل
الساق، مجمع الساق مع الرجل، فالمسح للرجلين باطل؛ لأن المشهور من قراءة
الآية: الفتح، عطف على المغسولات، على (وجوهكم وأيديكم) [المائدة:6]
وأدخل الممسوح بين المغسولات من أجل الترتيب، ولو أخر لفهم أن مسح الرأس
يكون بعد غسل الرجلين.
أما قراءة (وأرجلكم) بالجر فهي صحيحة، ولكن عنها أربعة أجوبة الجواب
الأول أن وجه الجر هنا على المجاورة، وهذه لغة عند العرب، مثل أن تقول:
هذا جحر ضب خربٍ، خربٍ ليست صفة لضب، إنما هي صفة لجحر، وجحر مرفوع.
ولكن من أجل المجاورة، ومن أجل سهولة النطق جُرّت للمجاورة.
والثاني: أن المراد بالمسح: الغسل، فالغسل يسمى مسحاً، تقول: تمسحت
بالماء، يعني اغتسلت به، فالمراد بمسح الرجلين غسلهما، بدليل قراءة
النصب.
الجواب الثالث: أن المشهور من القراءتين: قراءة النصب وهنا لا إشكال.
الجواب الرابع: أن غسل الرجلين هو صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم
التي نقلها عنه أصحابه، لم يرد في حديث واحد –ولو ضعيف- أن رسول الله
عليه الصلاة والسلام مسح رجليه، وكذلك ما ثبت ذلك عن أصحابه، بل لما رأى
صلى الله عليه وسلم رجلاً في رجله لمعة لم يصبها الماء، أمره بإعادة
الوضوء، وقال عليه الصلاة والسلام: "ويل للأعقاب من النار"( )؛ لأن
صاحبها يغفل عنها، وقد لا يصيبها الماء وذلك بسبب التساهل والغفلة،
والأمر في هذا واضح.
(186) والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين: برهم وفاجرهم،
إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما:
تقدمت مسألة الصلاة خلف الأئمة، سواء كانوا أبراراً أو فجّاراً، فنصلي
خلفهم امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أمرنا بطاعتهم،
ونهانا عن مخالفتهم، والصحابة –رضوان الله عليهم- امتثلوا أمره، فكانوا
يصلون خلف الأمراء، وإن كانوا يفعلون بعض الكبائر، مثل الحجاج وغيره.
وهذا الفعل من أجل جمع الكلمة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، خلاف
الخوارج والمعتزلة.
وقوله: (نرى الحج والجهاد): يجب على المسلمين كل سنة أن يقيموا الحج، أما
الأفراد: فإذا حج أحدهم مرة واحدة فإنه تكفيه، ومن زاد فتطوع.
والذي يقيم الحج؟ هو إمام المسلمين هو الذي يقود الحجيج، ويعلن يوم عرفة،
ويقف بهم بعرفة، ويفيض إلى مزدلفة، وهكذا يتبعونه في المشاعر، وسواء
الإمام أو من ينوب عنه، ولا يكون الأمر فوضى.
وأهل السنة والجماعة يحجون مع إمامهم، قال عليه الصلاة والسلام: "الصوم
يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس"( ).
هذه أمة الإسلام، يصومون جمعياً إذا اتفقت المطالع، ويحجون جميعاً،
ويصلون العيد جميعاً، فالجماعة من سمة أهل السنة، والافتراق من سمة أهل
البدع والضلال. والجهاد: المراد به: قتال الكفار والبغاة من المسلمين
وقتال الخوارج، نقاتل مع إمام المسلمين؛ فنقاتل البغاة لبغيهم وليس
لكفرهم (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما
على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله) [الحجرات:9].
وقتال الكفار من أجل نشر التوحيد، وقمع الشرك.
وقتال الكفار على نوعين:
النوع الأول: قتال دفاع، وهذه الحالة تكون في حالة ضعف المسلمين، فإنه
إذا داهم العدو بلادهم وجب عليهم قتالهم، فيجب على جميع من يحمل السلاح
قتالهم؛ من أجل دفع العدو عن أرضهم.
النوع الثاني: قتال طلب، وذلك إن كان المسلمون أقوياء، فإنهم يغزون العدو
في بلادهم، ويدعونهم إلى الله، فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء
كلمة الله (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)
[الأنفال:39].
ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهاد مر بمراحل:
المرحلة الأولى: كان منهياً عنه فيها، وهذا يوم كان النبي صلى الله عليه
وسلم والمسلمون بمكة، فكانوا مأمورين بكف الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة (ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا
الزكاة) [النساء:77]، فالمنع لأن المسلمين لا يستطيعون وليس لهم دولة ولا
قوة، وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح والانتظار، إلى أن يأتي الفرج،
ومن قاتل في هذه المرحلة فإنه يكون قد عصى الله ورسوله؛ لأنه يترتب على
القتال في هذه المرحلة الإضرار بالمسلمين وبالدعوة، وتسلط الكفار على
المسلمين.
المرحلة الثانية: لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقامت
دولة الإسلام، أُذن له بالقتال ولم يؤمر (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا
وإن الله على نصرهم لقدير*الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا
ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً) [الحج:39،40] فأذن لهم بدون أمر،
فكانت هذه تهيئة لهم، فالأمور الشاقة يشرعها الله شيئاً فشيئاً؛ من أجل
التسهيل على النفوس.
المرحلة الثالثة: أُمر بقتال من قاتل، والكف عمن لم يقاتل (وقاتلوا في
سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)
[البقرة:190] وهذا يسمى قتال الدفع.
المرحلة الرابعة: لما قوي المسلمون، وكانت لهم شوكة، وللإسلام دولة،
أُمروا بالقتال مطلقاً (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد) [التوبة:5]، (وقاتلوهم
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) [الأنفال:39].
فأمر الله بالقتال مطلقاً، فلما صاروا متهيئين ولهم قوة وعندهم استعداد،
فشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو، غزوة بدر وأحد والخندق
وهكذا، حتى جاء الفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، ثم توفي رسول
الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصلت الردة فقاتلهم أبو بكر، فلما فرغ منهم
شرع في الجهاد للكفار، فجيّش الجيوش لقتال فارس والروم، وتوفي، ثم جاء
عمر رضي الله عنه فواصل الفتوح حتى أسقط دولة كسرى وقيصر، ونشر الدين
وصارت سيطرتهم على جميع الأرض مشارقها ومغاربها، هذا هو القتال في
الإسلام.
ومن ينظم القتال ويقوده؟ هو الإمام، فنحن نتبع الإمام، فإن أُمرنا بالغزو
نغزو، ولا نغزو بغير إذن الإمام؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه من صلاحيات الإمام
(يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم
إلى الأرض) [التوبة:38].
فالقتال من صلاحيات الإمام، فإذا استنفر الإمام الناس للقتال وجب على كل
من أطاق حمل السلاح، ولا يشترط في الإمام الذي يقيم الحج والجهاد أن يكون
غير عاصٍ، فقد يكون عنده بعض المعاصي والمخالفات، لكن ما دام أنه لم يخرج
من الإسلام فيجب الجهاد والحج معه، وصلاحه وقوته للمسلمين وفساده على
نفسه، أما الجهاد والحج ففي صالح المسلمين، كذلك الصلاة، فإن أصاب كنا
معه، وإن أخطأ فنتجنب إساءته، لكن لا نخرج ونشق عصا الطاعة، هذا مذهب أهل
السنة والجماعة، وعليه تقوم مصالح المسلمين.
أما أهل البدع والضلال فيرون الخروج على ولاة الأمور، وهذا مذهب الخوارج،
ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب .
(168) ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين:
الإيمان بالملائكة عليهم السلام هو أحد أركان الإيمان.
وهذه الأصول موجودة في القرآن (ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
والملائكة والكتاب والنبيين…) [البقرة:177]، (آمن الرسول بما أنزل إليه
من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) [البقرة:285] فنؤمن
بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله، وأنهم من عالم الغيب، لا نراهم، خلقهم
الله من نور( )، ووكل إليهم أموراً، يقومون بتنفيذها والقيام بها، كل له
عمل موكل به، ومع ذلك فهم يعبدون الله عز وجل لا يفترون (يسبحون الليل
والنهار لا يفترون) [الأنبياء:20]، (عباد مكرمون*لا يسبقونه بالقول وهم
بأمره يعملون) [الأنبياء:26،27] وهم أقسام، ومن أقسامهم:
الحفظة: وهم الذين وكل الله إليهم حفظ بني آدم، وحفظ أعمالهم، فكل عبد من
بني آدم معه أربعة يحفظونه بالليل والنهار، اثنان حفظة، واحد عن اليمين
وواحد عن اليسار، الذي عن اليمين يكتب الحسنات، والذي عن اليسار يكتب
السيئات (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) [ق:18]، وملكان آخران؛ واحد
أمامه وواحد خلفه، يحفظونه من الاعتداء عليه، ما دام الله قد كتب له
البقاء (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله) [الرعد:11]
فالملائكة يدفعون عنه الأخطار، فإذا تم الأجل تخلوا عنه، فأصابه ما كتب
الله له، فنحن نؤمن بهذا، وإذا آمنا بذلك فإننا نستحيي من الملائكة
الكرام، فلا نعمل أعمالاً سيئة، ولا نتكلم بألفاظ باطلة؛ لأنها تسجل
علينا.
(169) ونؤمن بملك الموت، الموكل بقبض أرواح العالمين:
قال سبحانه : (وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم
الموت توفته رسلنا) [الأنعام:61] يعني من الملائكة، فالرسل قد يكونون من
الملائكة، وقد يكونون من البشر (الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس)
[الحج:75]، (توفته رسلنا وهم لا يفرطون) [الأنعام:61]، (ولو ترى إذ يتوفى
الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) [الأنفال:50]، وقال في آية
أخرى: (يتوفاكم ملك الموت) [السجدة:11].
ففي بعض الآيات أسند الموت إلى الملائكة، وفي بعض الآيات أسند إلى ملك
واحد، فدل هذا على أن الملائكة لهم رئيس هو ملك الموت.
ومسألة الموت لا أحد ينازع فيها، أما ملك الموت وأعوانه فينكرهم بعض بني
آدم، ولكن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإسلام والإيمان الثابتة
بالكتاب والسنة، فمن أنكر وجود الملائكة عموماً أو ملكاً من الملائكة فهو
كافر؛ لأنه جحد ركناً من أركان الإيمان.
(170) وبعذاب القبر لمن كان له أهلاً، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه
ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم، وعن الصحابة رضوان الله عليهم:
ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه
كل ما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه ومن البعث ومن العرض والحساب
والميزان وتطاير الصحف والجنة والنار، ومن أنكر شيئاً منها فإنه لا يكون
مؤمناً باليوم الآخر.
واليوم الآخر وما فيه من أمور الغيب التي لا ندخل فيها بعقولنا وأفكارنا،
إنما نعتمد على ما جاء في الكتاب والسنة، ولا نتدخل في هذه الأمور، ولا
نقول فيها إلا بالدليل .
والقبر برزخ بين الدنيا والآخرة والبرزخ معناه الفاصل بين شيئين (ومن
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) [المؤمنون:100].
القبر محطة انتظار، وينتقل الناس بعده إلى البعث والحساب، وذكر ابن القيم
رحمه الله أن الدور ثلاث:
الأولى: دار الدنيا: وهي محل العمل والكسب من خير أو شرف.
الثانية: دار البرزخ، وهي دار مؤقتة، ولهذا يخطئ من يقول مثواه الأخير.
الثالثة: دار القرار، وهي الجنة أو النار: (وإن الآخرة هي دار القرار)
[غافر:39].
فإذا وضع الميت في قبره ودفن وانصرف الناس عنه، وإنه ليسمع قرع نعالهم،
كما في الحديث، فإنه تُعاد روحه في جسده، وهذه حياة برزخية لا يعلمها إلا
الله، والله على كل شيء قدير، وبعد أن تُعاد روحه في جسده ويُحيى حياة
أخرى فيأتيه ملكان فيسألانه ثلاثة أسئلة:
من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟( )
فإن أجاب بجواب صحيح فاز وربح، وصارت حفرته روضة من رياض الجنة، ثم يوم
القيامة يصير من أهل الجنة. وإن أخفق في الجواب، ولم يجب، فإن قبره يصير
حفرة من حفر النار، ويُضيّقُ عليه قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، والأول
يوسع له في قبره مد بصره، ويفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها
وريحانها، وهذا يضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه، ثم يفتح له باب
من النار فيأتيه من حرها وسمومها، والعياذ بالله.
فالإجابة الصحيحة والتي يُثبت الله قائلها: أن يقول: ربي الله، وديني
الإسلام، ونبيّ محمد صلى الله عليه وسلم (يثبت الله الذين آمنوا بالقول
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) [إبراهيم:27].
وهذا بسبب الإيمان بالله ورسوله، وليس بسبب التعلم أو الثقافة، فمن ليس
عنده إيمان فإنه يتلكأ في الإجابة، وهو المنافق الذي يُظهر الإيمان في
الدنيا ويُبطن الكفر، فإنه لا يستطيع الإجابة ويقول: هاه، هاه، لا أدري،
سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل شيء إلا
الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق (ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما
يشاء) [إبراهيم:27].
(171) والقبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران:
قد يقول قائل: الميت يصير تراباً، فكيف يعذب وهو تراب؟ نقول: الله قادر
على أن يعذبه وهو تراب، وقادر على أن يحمي عليه التراب.
وقد يقول قائل : ما كل الناس يدفنون، بعضهم يُلقى في البحر، وبعضهم تأكله
السباع، فكيف يأتيه العذاب؟ نقول: نعم يأتيه العذاب، في أي مكان كان،
وكذلك يأتيه الملكان، والإيمان بهذا هو من الإيمان بالغيب، ومن الإيمان
بخبر الله ورسوله، أما الذي لا يؤمن بذلك ويعتمد على عقله وفكره، فهذا هو
الضلال المبين.
وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة، بل قال العلماء: إن
الأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب بالأمر
المتواتر يكون كافراً.
فالمعتزلة لا يؤمنون بما يحدث في القبر؛ لأنهم عقلانيون، وهم الذين يبنون
الأمور على عقولهم، ويسمون أدلة الشرع ظنية، فأما أدلة العقل عندهم فهي
يقينية، فهكذا يقولون، وهؤلاء هم العقلانيون، وهم المعتزلة ومن سار على
نهجهم من العقلانيين في هذه العصور.
ومن أدلة عذاب القبر: قول الله عز وجل في قوم فرعون: (النار يعرضون عليها
غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب) [غافر:46]
فقوله: النار يعرضون عليها غدواً وعشياً، هذا في القبر.
(وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون) [الطور:47]
فقوله: (عذاباً دون ذلك) قالوا: إنه عذاب القبر.
وقيل هو : العذاب في الدنيا: ما يصيبهم من القتل والسبي وضرب الجزية وغير
ذلك، والآية تشمل المعنيين، وقوله تعالى: (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى
دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون) [السجدة:21] العذاب الأدنى هو عذاب
القبر، والأكبر هو عذاب يوم القيامة.
أما السنة فتواترت الأحاديث بإثبات عذاب القبر، منها: في الصحيح أنه عليه
الصلاة والسلام مر على قبرين فقال: "إنهما ليعذبان، ولا يعذبان في كبير،
أما أنه كبير -أو : بلى إنه لكبير- أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما
الآخر فإنه لا يستبرئ من بوله" ( ).
وكذلك الحديث الصحيح الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة
من أربع "أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا
والممات، ومن فتنة المسيح الدجال"( ).
وغير ذلك من الأدلة، وقد يشاهد بعض الناس ما يحصل من عذاب القبر من أجل
العظة والعبرة.
ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه " أهوال القبور وأحوالها أهلها إلى يوم
النشور" ذكر عجائب، وذكر ابن القيم في كتابه "الروح" عجائب.
وقوله: (على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ لأن
ما في القبر من النعيم والعذاب من أمور الغيب، فلا نثبت إلا ما جاء به
الدليل، ولا ننكر ما جاء به، هذا مذهب أهل السنة والجماعة.
(172) ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة
الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان:
بعد البرزخ يبعث الناس من قبورهم، فهذه القبور تضم الأجساد وتحفظها، فإذا
جاء البعث فإن الله ينشئ هذه الأجسام كما خلقها أول مرة، لا ينقص منها
شيء (كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين)
[الأنبياء:104].
فتعاد كما كانت، بحيث لو مر شخص على رجل يعرفه لقال: هذا فلان، ثم يأمر
الله إسرافيل فينفخ في الصور النفخة الثانية، فتطير الأرواح إلى أجسادها.
والمحشر: مجمع الأمم، يجمع الله الأولين والآخرين بعد البعث، فالله على
كل شيء قدير، والإيمان بالعبث أحد أركان الإيمان الستة، كما في الحديث.
وأنكر البعث المشركون والملاحدة بناء على عقولهم، فقالوا: (أئذا متنا
وكنا تراباً وعظاماً أءنا لمبعوثون*أو آباؤنا الأولون) [الواقعة:47،48]
وذكر الله إنكارهم هذا في عدة مواضع، مثل: (قال من يحي العظام وهي رميم)
[يس:78].
والله عز وجل ذكر أدلة عقلية على البعث (وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده
وهو أهون عليه) [الروم:27]. وهذا من باب ضرب المثل، فالذي خلقهم من ماء
مهين، ألا يقدر أن يخلقهم من تراب ويعيدهم كما كانوا؟ (أيحسب الإنسان أن
يترك سدى*ألم يك نطفة من مني يمنى*ثم كان علقة فخلق فسوى* فجعل منه
الزوجين الذكر والأنثى*أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى)
[القيامة:36:40].
ومن الأدلة: إحياء أرض يابسة قاحلة بيضاء ما فيها شيء، ثم ينـزل الله
عليها المطر، ففي أيام قليلة تهتز بالنبات.
أليس الذي يحيي الأرض بعد موتها بقادر على أن يعيد خلق الإنسان؟ فهذا شيء
معقول وشيء محسوس (وآية لهم الأرض الميتة أحييناها) [يس:33] بعد أن كانت
ميتة فأحياها بالنبات (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت
وربت) [الحج:56].
ومن الأدلة على البعث أيضاً: أن الله عز وجل لو لم يبعث الناس ويجازيهم
لكان خلقه عبثاً، والله سبحانه وتعالى منـزه عن العبث (أفحسبتم أنما
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون * فتعالى الله الملك الحق)
[المؤمنون:115،116].
فالإنسان الذي يفني نفسه بالعبادة والطاعة في الدنيا فيموت ولا يبعث!؟
كذلك الكافر يعيث في الأرض فساداً ويفعل الفواحش ويموت ولا يبعث!؟ هذا لا
يكون من حكمة الله (أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) [الجاثية:21]، وقال
سبحانه: (أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون) [القلم:35،36]،
(وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا فويل
للذين كفروا من النار* أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في
الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) [ص:27،28].
فالمؤمن قد لا ينعم في الدنيا، ويكون في ضيق وشدة، فلا ينال جزاء عمله!؟
والكافر ينعم ويبطش ويفسد في الأرض ولا ينال جزاءه!؟ هذا لا يليق بحكمة
الله عز وجل.
والبعث معناه القيام من القبور (يوم يقوم الناس لرب العالمين)
[المطففين:6] (وجزاء الأعمال) كما سبق: أن المحسنين والمسيئين لا ينالون
جزاءهم في الدنيا، إنما ذلك في دار الآخرة.
(والعرض) يعني: على الله (يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية) [الحاقة:18]،
(وعرضوا على ربك صفاً لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة) [الكهف:48]
يعرضون على الله عز وجل حفاة عراة، غرلاً، أي : غير مختونين.
(والحساب) على الأعمال: تقرير الحسنات وتقرير السيئات، هذا بالنسبة
للمؤمنين، أما الكافر فإنه لا يحاسب حساب موازنة بين حسناته وسيئاته،
وإنما يقرر بذنوبه وكفره؛ لأنه ليس له حسنات.
والمؤمنون منهم من يدخل الجنة بغير حساب، ومنهم من يحاسب حساباً يسيراً
وينقلب إلى أهل مسروراً، وهو العرض، ومنهم من يُناقش الحساب، وفي الحديث
: "من نوقش الحساب عُذِّب"( ). وهذه درجات المؤمنين .
(والكتب) : صحائف الأعمال التي عملوها في الدنيا، كل يعطى يوم القيامة
كتابه وصحيفة أعماله التي عملها في الدنيا، مكتوب فيها كل شيء (ووضع
الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) [الكهف:49]، وقال سبحانه: (وكل
إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً*
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً) [الإسراء:13،14]، وقال سبحانه:
(فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه * إني ظننت أني
ملاق حسابيه* فهو في عيشة راضية* في جنةٍ عالية) [الحاقة: 19،22] فهذا
الصنف من الناس يفرح ويسره أن يطلع الناس على كتابه.
(وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول ياليتني لم أوت كتابيه * ولم أدر ما
حسابيه* ياليتها كانت القاضية) [الحاقة:25،27] يعني : يا ليتني لم أبعث،
وكان الموت هو القاضي عليّ ولم أبعث (ما أغنى عني ماليه* هلك عني
سلطانيه) [الحاقة: 28،29].
وهذا تطاير الصحف، إما باليمين أو بالشمال.
(والثواب والعقاب) الثواب على الحسنات، والعقاب على السيئات.
(والصراط) وهو: الجسر المنصوب على متن جهنم، أحدُّ من السيف، وأدَقُّ من
الشعر، وأحرُّ من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر
كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم
من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يمر عدواً ومنهم من يمر مشياً، ومنهم من
يمر حبواً، ومنهم من تلقطه كلاليب على حافتي الجسر وتقذفه في النار، وهذه
أمور غيب، فلا يُدخلُ الإنسان عقله فيها، وكل الناس يمرون على الصراط
(وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً* ثم ننجي الذين اتقوا
ونذر الظالمين فيها جثياً) [مريم:71،72].
وتوزن الحسنات، فإن رجحت حسناته فاز، وإن رجحت سيئاته على حسناته خاب
وخسر (والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون* ومن خفت
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون) [الأعراف
:8،9].
وتكرر ذكر الوزن والميزان في آيات كثيرة، وهذا من عدل الله عز وجل، وأنه
لا يظلم أحداً. والميزان حقيقي، له كفتان: توضع الحسنات في كفّه، وتوضع
السيئات في كفة، فأيهم رجحت حسناته فاز، وأيهم رجحت سيئاته فخسر (ونضع
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين) [الأنبياء:47].
(173) والجنة والنار مخلوقتان، لا تفنيان أبداً ولا تبيدان:
ومما يكون في يوم القيامة: الجنة دار المتقين، والنار دار المجرمين، قال
الله تعالى في الجنة: (أعدت للمتقين) [آل عمران:133]، وقال في النار:
(أُعدت للكافرين) [البقرة:24] فهما داران باقيتان، وهما المستقر
والنهاية. (وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلاً)
. والجنة والنار مخلوقتان الآن، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، قال تعالى:
(أُعدت للمتقين)، وقال: (أُعدت للكافرين) وأعدت: فعل ماضٍ، والنبي صلى
الله عليه وسلم كان عنده أصحابه، فسمعوا وجبة، يعني: شيء سقط، فقال:
"أتدرون ما هذا؟" قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "هذا حجر رمي به في جنهم
منذ سبعين خريفاً، والآن وصل إلى قعرها"( ) فدل على أن النار قد خلقت.
وقال عليه الصلاة والسلام في الحر والبرد: "إنهما نفسان لجنهم: نفس في
الشتاء وهو أشد ما تجدون من البرد، ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من
شدة الحر"( ) ، وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا اشتد الحر فأبردوا
بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جنهم" ( )، وكذلك الميت في قبره يفتح له
باب إلى الجنة، والكافر باب إلى النار، فهذا يدل على وجود الجنة والنار،
وأنكر هذا أهل الضلال، ويقولون: تخلقان يوم القيامة.
(174) وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلاً:
الله قدر للجنة أهلاً، وكذلك للنار أهلاً، فعلى حسب عملهم يجازون.
(175) فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه. ومن شاء منهم إلى النار عدلاً
منه:
الجنة لا تُنال بالعمل، إنما هو سبب، وإنما الجنة تنال بفضل الله، فمهما
عمل ابن آدم من الأعمال الصالحة وإن كثرت فإنها لا تقابل الجنة، إنما
تنال بفضل الله عز وجل، والعمل الصالح سبب (ادخلوا الجنة بما كنتم
تعملون) [النحل:32] أي: بسبب ما كنتم تعملون.
ودخول النار بسبب الكفر، عدلاً من الله، أدخله النار، لا بظلم، إنما
أدخله بسبب عمله.
ا 1
ا 2 ا
3 ا
4 ا
5 ا |