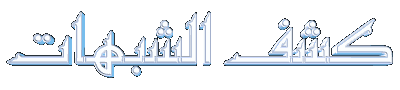|
التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية
للدكتور صالح بن فوزان
الفوزان
ا 1
ا 2 ا
3 ا 4
ا 5 ا
(176) وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خُلق له:
إن كان من أهل السعادة فإنه يعمل بعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل
الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة، قال عليه الصلاة والسلام: "اعملوا فكل
ميسر لما خلق له"( ).
وقال تعالى : (إن سعيكم لشتى* فأما من أعطى وأتقى* وصدق بالحسنى*
فسنيسره لليسرى* وأما من بخل واستغنى* وكذب بالحسنى* فسنيسره للعسرى)
[الليل:4،10]. فالأعمال هي التي تحكمك، إن كانت صالحة فأنت ميسر لليسرى،
وإن كانت سيئة فأنت ميسر للعسرى.
(177) والخير والشر مقدران على العباد:
سبق بحث هذا في القدر، والإيمان بالقدر –كما سبق- هو أحد أركان
الإيمان الستة، كما قال عليه الصلاة والسلام: "الإيمان أن تؤمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره"( ) .
والمؤلف أخذ هذا المعنى من نص الحديث.
فالخير والشر بتقدير الله عز وجل؛ لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا
بقضاء الله وقدره، لابد من الإيمان بذلك.
فالله عز وجل خلق الخير والشر لحكمة (ونبلوكم بالشر والخير فتنة
وإلينا ترجعون) [الأنبياء:35] يتميز بذلك أهل الإيمان والتوحيد ولانقياد
لله، وأهل الكفر والشرك والإلحاد، ولو لم يكن هناك خير لما حصل التمييز.
فالخير يحبه الله ويخلقه ويقدره، والشر يبغضه الله ويسخطه، ولكن يخلقه
ويقدره لحكمة، للابتلاء والامتحان، لو لم يوجد الشر ما ظهر الكفر وعداوة
الأنبياء والرسل، ولو لم يوجد الخير لما ظهر الجهاد والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر والموالاة والمعاداة، ولا تميز الناس.
قد يعترض معترض ويقول: الله يبغض الشرك والكفر، فكيف يقدر ذلك؟ ونقول:
قدر ذلك لحكمة؛ ليتميز الناس (ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم
عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب) [آل
عمران:179] فنحن لا نعلم المطيع من العاصي إلا بالأعمال، فهي تميز الشقي
من السعيد.
فالأمور لا تصلح إلا إذا وجدت المتضادات.
(178) والاستطاعة التي يجب بها الفعل، من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن
يوصف المخلوق به –فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع،
والتمكن وسلامة الآلات –فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال
تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) :
الاستطاعة هي القدرة من الإنسان، وهي على قسمين:
الأول: استطاعة يتعلق بها التكليف والأمر والنهي.
الثاني: استطاعة يستطيع بها الإنسان الفعل والتنفيذ.
القسم الأول: الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف، معناها: الوسع، أن
يكون عند الإنسان وسع، أن يفعل أو لا يفعل، عنده إمكانية وتمكن، فالتكليف
يتعلق بهذه الاستطاعة، فالإنسان الذي ليس عنده تمكن واستطاعة لا يكلف،
كالمجنون والصغير، فلا يكلف فلا يُؤمر ولا يُنهى، ولكن الصغير إن بلغ سبع
سنوات فإن عنده استطاعة فيُؤمر بالصلاة من باب الاستحباب والتربية،
والتدريب على فعل العبادة، فلا تجب عليه إلا إذا بلغ فيكلف، وهذا النوع
يكون قبل الفعل.
القسم الثاني: الاستطاعة التي يكون فيها التنفيذ، وإيجاد الشيء، فهذه
تكون مع الفعل فالحج مثلاً فيه الاستطاعتان، قال تعالى: (ولله على الناس
حج البيت من استطاع….) [آل عمران:97] فهذه استطاعة تمكن، فيجب الحج على
من يستطيع، والسبيل هو الزاد والراحلة، فيجب عليه الحج إذا وجدهما؛ لأن
عنده تمكناً، هذه استطاعة قبل الفعل، أما الاستطاعة مع الفعل –وهو مباشرة
الحج- فقد لا يكون عنده قدرة مثل المريض المزمن أو الكبير الهرم، فهذا لا
يستطيع استطاعة تنفيذ وفعل، ويستطيع استطاعة تكليف، فهذا يجب عليه الحج
في ذمته.
ومثل دخول وقت الصلاة يوجب الصلاة على المكلف، ويكون التنفيذ بحسب
استطاعته، فالمريض يصلي قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً، فإن لم يستطع فعلى
جنب، فالصلاة تجب عليه على كل حال؛ لأنه في استطاعته ذلك، وهذه الاستطاعة
قبل الفعل، أما التي مع الفعل قد تكون معدومة نهائياً، وقد تكون موجودة،
ولكن ليست تامة، فيجب عليه على قدر استطاعته.
(فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن:16]، (لا يكلف الله نفساً إلا
وسعها) [البقرة:286].
وفيه فرق بين الاستطاعتين:
فالأولى يتعلق الخطاب بها، كما قال تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا
وسعها) [البقرة:286]، والثانية يتعلق بها التنفيذ.
(179) وأفعال العباد خلق الله، وكسب من العباد:
هذه المسألة حصل فيها نزاع ومزلة أقدام ومضلة أفهام، هل الأفعال
مخلوقة لله أو هي من خلق العباد؟
القول الأول: قول الجبرية والجهمية: إن العبد مجبور، ليس له دخل في
الأفعال، فهي محض خلق الله عز وجل، فصلاته التي يؤديها ليس باختياره،
إنما هو مجبور وهؤلاء غلوا في إثبات قدرة الله.
وقولهم هذا ضلال مبين، ومعناه أن الله يظلمهم ويعذبهم على شيء ليس لهم
فيه اختيار، وليس لهم فيه استطاعة، وإنما الله يعذب العبد على فعل غيره،
ويثيبه على شيء لم يفعله، وهذا المذهب أخبث المذاهب.
القول الثاني: وهو مضاد للقول الأول تماماً، وهو قول المعتزلة،
يقولون: الأفعال من إنتاج العبد وإرادته المطلقة ومشيئته، وليس لله تدخل
فيها، وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فهؤلاء غالوا في إثبات قدرة
العبد.
ويلزم من قولهم أن الله عاجز، وأن الله يشاركه غيره في الخلق
والإيجاد، وهذا قول المجوس، ولذلك المعتزلة سُمُّوا: مجوس هذه الأمة( )،
فالمجوس يقولون: إن للكون خالقين، خالق للخير وخالق للشر، والمعتزلة
زادوا عليهم وقالوا: كل يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين.
والمذهب التوسط مذهب أهل السنة والجماعة، على ضوء الكتاب والسنة،
قالوا: أفعال العباد هي فعلهم بإرادتهم ومشيئتهم، وهي خلق الله عز وجل
(والله خلقكم وما تعملون) [الصافات:96] (الله خالق كل شيء وهو على كل شيء
وكيل) [الزمر:62] (هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض)
[فاطر:3] فالله منفرد بالخلق والتقدير، والعبد له مشيئته وإرادته، وله
فعل، فهو باختياره يذهب إلى المسجد، وباختياره يذهب إلى المسارح؛ لأن
عنده قدرة، والإنسان الذي لم يعطه الله قدرة ولا استطاعة فهذا قد عذره
الله، مثل المجنون والمكره، فليس عنده إرادة، وليس عنده قصد، أما من عنده
إرادة وقصد، فهذا الذي يختار الفعل لنفسه، والعقاب والثواب يقع على فعله،
وليس على فعل الله عز وجل.
قال الله تعالى: (إن الذين آمنوا) [البقرة:62] [النساء:59]، (إن الذين
كفروا) [آل عمران:116] أسند الإيمان إليهم، وكذلك أسند الكفر (أطيعوا
الله وأطيعوا الرسول) [النساء:59] (ومن يطع الله ورسوله) [النور:52] أسند
الأفعال إلى العباد.
والدليل على أن العبد له إرادة وقصد: قوله تعالى: (وما تشاءون إلا أن
يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً) [الإنسان:30]، فأثبت الله سبحانه
له مشيئة وللعبد مشيئة، وجعل مشيئة العبد تحت مشيئته سبحانه (لمن شاء
منكم أن يستقيم) [التكوير: 28] شاء، أي: باختياره، وفي هذا رد على
الجبرية. (إلا أن يشاء الله) [الإنسان:30] في هذا رد على القدرية.
(180) ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون:
قال تعالى: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) [البقرة:286]، (ربنا ولا
تحملنا ما لا طاقة لنا به) [البقرة:286]، (يريد الله بكم اليسر ولا يريد
بكم العسر) [البقرة:185]، فالله لا يكلف العباد ما لا يطيقون، إلا من باب
العقوبة، كما حمّل بني إسرائيل بسبب تعنتهم (فبظلم من الذين هادوا حرمنا
عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً* وأخذهم الربا)
[النساء:160،161]، فالله عاقبهم فكلفهم بما لا يطيقون، ولذلك جاء في
الدعاء (ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا)
[البقرة:286] فالله –فضلاً منه وإحساناً- لا يكلف العباد إلا ما يطيقون،
رحمة منه، فهو رحيم (إن الله بالناس لرءوف رحيم) [البقرة:143].
(181) ولا يطيقون إلا ما كلفهم:
هذا فيه نظر؛ بل يطيقون أكثر مما كلفهم، ولكن الله يريد بهم اليسر ولا
يريد بهم العسر، فالله وضع عنهم المشقة، وشرع لهم الدين اليسر، ونهاهم عن
الزيادة على الاعتدال، فلا يجوز للإنسان أن يصلي كل الليل، وكذلك لا يجوز
له ترك الزواج، قال عليه الصلاة والسلام: "أما أنا فأصلي وأنام وأتزوج
النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني"( )، فالله لا يكلف ما يشق
عليهم، والله لو كلفهم لأطاقوا، ولكن لا يرضى لهم المشقة والعسر.
(182) وهو تفسير: "لا حول ولا قوة إلا بالله" . نقول: لا حيلة لأحد،
ولا حركة لأحد ولا تحوّل لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة
لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله:
(لا حول) أي: لا تحول من حال إلى حال (إلا بالله) عز وجل وإعانته.
وكذلك: ليس لك قوة إلا من قوة الله عز وجل، ففي هذا تسليم وبراءة من
الحول والقوة، فالإنسان لا يُعجب بحوله ولا بقوته، وإنما يرجع إلى الله
عز وجل، فتستعين بالله، فيعينك على الطاعة، ومن التحول من المعصية إلى
الطاعة، ومن الكفر إلى الإسلام، فكل شيء بحول الله وقوته، ولو وكلك إلى
حولك لم تستطع، وكذلك الكد والكسب لطلب المال، هذا الكد والتعب منك، ولكن
التوفيق ووضع البركة من الله عز وجل.
(183) وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره:
لا يقع في ملكه شيء إلا بعلمه وتقديره (وما تشاءون إلا أن يشاء الله
رب العالمين) [التكوير:29].
فهو ما قضاه وقدره، وكتبه في اللوح المحفوظ، فكل ما يجري في الكون فهو
بقضاء الله وقدره.
(184) غلبت مشيئته المشيئات كلها:
قال تعالى : (وما تشاءون إلا أن يشاء الله) [التكوير:29] اثبت للعبد
مشيئته، ولكنها داخلة تحت مشيئة الله، وأن العبد لا يستطيع المشيئة إلا
بمشيئة الله.
(185) وغلب وقضاؤه الحيل كلها:
مهما عملت من الأسباب ومن الأمور، إذا لم يقدر الله المسبب فلا تنفعك
الأسباب، وجميع الأعمال لا تنفع إذا لم يُقدِّر الله عز وجل لك النفع
بها، فأنت عليك فعل السبب، والتوفيق على الله، فأنت مأمور بفعل الأسباب.
(186) يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبداً، تقدّس عن كل سوءٍ وحين،
وتنـزه عن كل عيب وشين.
فالله يفعل ما يشاء من الخير والشر، والنعمة والنقمة، وهو غير ظالم
لعباده؛ لأنه يضع الأشياء في مواضعها، فيضع النعمة والتوفيق لمن يتأهل
لذلك، ويحرم من التوفيق ومن الطاعة من لا يستحق ذلك، وهو غير ظالم، فلا
يعذب المطيع الصالح، ولا يثيب العاصي على معصيته.
فالله سبحانه الكامل في ذاته، والكامل في أسمائه وصفاته، والكامل في
أفعاله وخلقه سبحانه وتعالى.
(187) (لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون) :
وكذلك لا يُسأل سبحانه عما يفعل؛ لأن كل شيء يفعله لحكمة، وواقع
موقعه، فأما العباد فيسألون؛ لأنهم يخطئون، ويضعون الأمور في غير
مواضعها، ففيه فرق بين الخالق والمخلوق، فالله لا يقع في أفعاله خلل، أما
العبد فعنده ظلم وحسد وكبر، وعنده أمور تقتضي أنه يخطئ في أموره
وتصرفاته.
(188) وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات:
هذه مسألة فقهية، ولها تعلق بالعقيدة:
قال عليه الصلاة والسلام: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:
صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"( ).
فالعبد ينقطع عمله بموته، إلا ما تسبب في بقائه بعد موته، مثل الصدقة
الجارية، كوقف مسجد أو مدرسة يدرس فيها، فما دام نفعها فأجرها يجري ما
دام هذا الوقف ينتفع به.
(أو علم) بأن يكون قد درّس الفقه أو العقيدة، وصار له تلاميذ، فيجري
عليه أجر تعليمه، أو ألّف كتباً تنفع الناس، فيجري أجره، وهذا من العلم
الذي علَّمه.
(أو ولد صالح يدعو له) فهو تزوج من أجل إعفاف نفسه، وطلباً للذرية
الصالحة، فجاءه ولد صالح، وهذا مما تسبب فيه، قال عليه الصلاة والسلام:
"إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم"( ) .
فإن كان صالحاً يدعو له بعد موته، فإن دعاءه يصل إليه، وهذا من عمله
الذي تسبب فيه فينفعه عمل غيره.
وغير هذه المسألة محل الخلاف، قال سبحانه: (وأن ليس للإنسان إلا ما
سعى) [النجم:39] منطوق الآية: أن عمل الإنسان لا ينفع غيره، إلا ما تسبب
فيه، فأخذ طائفة من العلماء بهذه الآية، وقال: لا ينفعه إلا عمله مطلقاً،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء تنفع الميت من عمل غيره، مثل
الدعاء والاستغفار (ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان)
[الحشر:10] (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) [محمد:19]، هذا يشمل
الأموات أيضاً.
والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا دفنوا أخاهم أن يقفوا على
قبره، وأن يستغفروا له ويسألوا له التثبيت( )، كذلك الصدقة تنفع الميت،
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن أمة ماتت، ولو تكلمت
لتصدقت، أفأتصدّق عنها؟ قال: "نعم"( ).
كذلك الحج ينفع غيره، كما جاءت به الأدلة، كما في حديث شبرمة، قال
عليه الصلاة والسلام: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"( ) فهذا عمل للغير
ينفع الميت، كذلك لما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج
عن أمها: أنها أدركتها فريضة الحج ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: "نعم، حجي
عن أمك" ( ). فتكون هذه الأشياء: الدعاء والاستغفار والصدقة والحج
والعمرة، تكون نافعة للميت من عمل غيره، فتكون مخصصة للآية (وأن ليس
للإنسان إلا ما سعى) [النجم:39].
وغلت طائفة في هذا وقالت: ينفع الميت كل شيء من عمل غيره، فيستأجرون
المقرئين يقرءون للميت، فمثل هذا العمل لا ينفع الميت ولا الحي؛ لأن
القارئ أخذ على قراءته أجرة، فليس له ثواب، ومن ناحية ثانية: أن هذا
الأمر مبتدع، ليس عليه دليل، وسبحان الله! لو جعل الأجرة التي يعطيها
المقرئ صدقة عن الميت صار تابعاً للسنة وينفع الميت، أما على وجه البدعة
فلا ينفع الميت ولا الحي، وهذا نتيجة ترك السنة.
(189) والله تعالى يستجيب الدعوات، ويقضي الحاجات:
هذه من صفات الله عز وجل أنه يجيب من دعاه، قال سبحانه (وإذا سألك
عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان) [البقرة:186] .
وأمر الله عز وجل بدعائه فقال: (ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) [غافر:60]، وقال سبحانه: (أمن يجيب
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض) [النمل:62] إلى غير
ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالدعاء وإجابة الدعاء، وهذا من كرمه
وجوده وإحسانه، يأمر عباده بدعائه ليستجيب لهم، مع أنه غني عنهم، ولكن
لعلمه سبحانه وتعالى بحاجتهم أمرهم بدعائه، وفي الحديث: "من لا يسأل الله
يغضب عليه"( ).
والدعاء أعظم أنواع العبادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "الدعاء هو
العبادة"( ).
وكما أنه أمر بدعائه، نهى عن دعاء غيره والإشراك به في الدعاء، فقال:
(وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا) [الجن:18]، (قل إنما ادعوا ربي
ولا أشرك به أحداً) [الجن:20]، (ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له
به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون) [المؤمنون:117].
فلا يجوز دعاء غير الله، ومن دعا غير الله فهو مشرك، سواء كان المدعو
ملكاً أو نبياً أو ولياً، فقد أشرك الشرك الأكبر (ومن أضل ممن يدعوا من
دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون) [الأحقاف:5]،
(إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة
يكفرون بشرككم) [فاطر:14] فسماه شركاً، وقال سبحانه (قل ادعوا الذين
زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم
فيهما من شرك وماله منهم من ظهير* ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له)
[سبأ:22،23].
فالدعاء لا يكون إلا لله، فلا يدعى أحد من دونه من الأحياء أو
الأموات، أيّاً كان هذا المدعو.
والدعاء على قسمين:
الأول: دعاء عبادة، وهو الثناء على الله عز وجل في أسمائه وصفاته
وأفعاله، فالذي يسبحه ويكبره ويحمده ويثني عليه قد دعاه دعاء عبادة.
الثاني: دعاء مسألة، وهو طلب الحوائج من الله عز وجل، وكلاهما تضمنته
سورة الفاتحة، فأولها إلى نصفها دعاء عبادة، إلى قوله (إياك نعبد) وآخر
السورة مسألة.
والعلماء يقولون: دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة
متضمن لدعاء العبادة.
والله عز وجل وعد من دعاه أن يستجيب له، وقد يقول قائل: أنا دعوت ولم
يستجب لي.
والجواب أن يُقال: المانع من عندك أنت، الدعاء سبب من الأسباب،
والنتيجة لا تحصل إلا إذا انتفت الموانع، فقد يكون مانع من الموانع منع
استجابة دعوتك، إما أن تكون دعوت بقلب غافل لاهٍ فأنى يُستجاب لقلب غافل
لاهٍ؟ كما في الحديث، أو أنك تأكل الحرام وتشرب الحرام وتلبس الحرام، قال
عليه الصلاة والسلام في الذي: "يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى
السماء: يا رب، يارب، يارب، ومطعمه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى
يُستجاب له"( )؟
أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فلا يُستجاب له، هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية: أن الله عز وجل أعلم بمصالحك، قد يعجل لك الإجابة
وقد يؤخرها، وقد يصرف عنك من السوء مثلها، وأنت لا تدري، كما في الحديث:
"ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها
إحدى ثلاث: إما أن يعجل دعوته، وإما أن يؤخرها له، وإما أن يصرف عنه من
السوء مثلها"( ).
أهل الضلال يقولون: لا حاجة للدعاء؛ لأن الأمر إذا كان قدر فلا يحتاج
إلى دعاء؛ لأنه إذا كان الأمر قدر لك فإنه سيأتيك، ولو لم تدع، وإن كان
لم يقض لك ويقدر فإنك لو دعوت لم يحصل لك ولا يقدر، وهذا ضلال، والعياذ
بالله، ومخالف لكلام الله عز وجل.
والجواب: أنه لا تعارض بين الدعاء والقضاء والقدر، الذي قضى وقدر هو
الذي أمر بالدعاء، والدعاء سبب من الأسباب، والمسبب هو الله عز وجل،
وهناك بعض الأشياء قدرت على أسباب، إذا وجدت أسبابها وجدت مسبباتها،
والدعاء سبب.
(190) ويملك كل شيء، ولا يملكه شيء:
من صفات الله عز وجل: أنه يملك كل شيء، فكل ما في الكون فهو ملك له
(تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير) [الملك:1]، وقال تعالى: (له
ملك السموات والأرض) [الحديد:2].
فلا يخرج شيء عن ملكه، والناس وما يملكون فهم ملكه سبحانه وتعالى: (قل
اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير) [آل عمران:26].
فلا أحد يفرض ويلزم ويملي على الله شيئاً؛ لأن الناس عباد لله فقراء
إليه، كما قال سبحانه: (وربك يخلق ما يشاء ويختار) [القصص:68]، وقال
سبحانه: (إن الله يفعل ما يشاء) [الحج:18].
وإنما هو سبحانه يدبر الأمر بمفرده، ويجريه على حكمته سبحانه وتعالى.
(191) ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين:
الله جل وعلا هو الغني الحميد، والخلق كلهم فقراء إلى الله، وما أحد
منهم يمكن أن يستغني عن الله.
قال تعالى: (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني
الحميد) [فاطر:15]. فلا أحد يمكن أن يستغني عن الله، ولو كان عنده ملك
الدنيا، فالملوك فقراء إلى الله، وكذلك الأغنياء، فلا أحد يستغني عن
الله، لا الملائكة المقربون ولا من دونهم من الخلق.
(192) ومن استغنى عن الله طرفة عين، فقد كفر وصار من أهل الحين:
من زعم أنه في غنىً عن الله، وأنه مستغن عن الله، فقد كفر وخرج من
الملة، فالواجب على العبد أن يظهر لله ضعفه، ولا يعجبه ما هو فيه من
القوة والصحة والغنى؛ لأن الأمور بيد الله عز وجل، فلا يمكن الاستغناء عن
الله عز وجل.
(193) والله يغضب ويرضى، لا كأحد من الورى:
من صفات الله عز وجل الفعلية: أنه يغضب ويرضى، قال سبحانه: (والسابقون
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم
ورضوا عنه) [التوبة:100] فالله يرضى عن عباده، قال تعالى: (ورضوان من
الله أكبر) [التوبة:72]، وقال تعالى: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ
يبايعونك تحت الشجرة) [الفتح:18]، وهو كذلك يغضب سبحانه وتعالى: (قل هل
أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه) [المائدة:60]
فالله يغضب على من عصاه ويمقته، والمقت هو أشد البغض، قال تعالى: (ومن
يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد
له عذاباً عظيماً) [النساء:93].
والمخلوق يغضب ويرضى، ولا مشابهة بين غضب ورضا المخلوق وغضب ورضا
الخالق، رضا الله وغضبه يليقان به سبحانه، ورضا وغضب المخلوق يليقان به
كسائر الصفات (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) [الشورى:11]، ليس له مثل
في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وإن كانت له أسماء وصفات، وللمخلوق
أسماء وصفات، فلا تشابه.
وهذا مذهب أهل السنة ولجماعة، يثبتون الرضا والغضب لله عز وجل وغير
ذلك من الصفات، وإن كان جنس هذه الصفات موجوداً في المخلوقين، لكن مع
الفارق (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) [الشورى:11] كذلك المخلوق سميع
بصير، وقال الله عن نفسه: (وهو السميع البصير) وقال في أول الآية: (ليس
كمثله شيء) فدل على أن هناك فرقاً بين صفات الخالق وصفات المخلوق وهذا
شيء معلوم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاد أهل
السنة والجماعة، أما أهل التأويل والضلال فينفون الأسماء والصفات عن
الله؛ لأن جنسها موجود في المخلوقين، ولو أثبتها اقتضى هذا المشابهة
–بزعمه- وفي الحقيقة هذا لا يقتضي المشابهة.
ولكن هذا الفهم عقيم، ويأولون الغضب بالانتقام، والرضا بالإنعام،
فالواجب التسليم لله ولرسوله وما ثبت عنهما، وأن يترك هذه الترهات
والتأويلات.
ولذلك لما سئل مالك عن كيفية استواء الله على عرشه؟ أطرق مالك رأسه
خوفاً وحياء من الله، ثم رفع رأسه وقال: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول،
والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة).
(194) ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
أصحاب: جمع صاحب، والصحابي هو: الذي لقي الرسول وهو مؤمن به ومات على
ذلك، فإن آمن به ولم يلقه فليس بصحابي، ولو كان معاصراً للنبي صلى الله
عليه وسلم، كالنجاشي، وكذلك يشترط الإيمان به والموت على ذلك، فبمجرد
الردة والموت عليها تبطل الصحبة وسائر الأعمال، وصحابة رسول الله صلى
الله عليه وسلم هم أفضل القرون والأمم بعد الأنبياء والرسل، وذلك لأنهم
أدركوا المصطفى عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وجاهدوا معه وتلقوا عنه
العلم، وأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم واختارهم الله لنبيه أصحاباً.
والله يقول: (لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم
ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً) [الفتح:18]،
وقال سبحانه: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجههم من أثر
السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فآزره
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغظ بهم الكفار وعد الله الذي
آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً) [الفتح:29]، والصحابة
أفضل القرون؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "خير القرون قرني ثم الذين
يلونهم ثم الذين يلونهم" فهم خير القرون بفضل صحبتهم للنبي عليه الصلاة
والسلام، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق، قال تعالى : (ليغيظ بهم الكفار)
[الفتح:29].
فالواجب على المسلمين عموماً حب الصحابة جميعاً، بنص الآية؛ لمحبة
الله عز وجل لهم، ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم جاهدوا في
سبيل الله، ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وآزروا الرسول
وآمنوا به واتبعوا النور الذي أُنزل معه، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة.
فالله لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشر، قال سبحانه:
(للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من
الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون * والذين تبوءو
الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة
مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك
هم المفلحون* والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا) [الحشر:8-10] فهذا
موقف المسلمين من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يستغفرون لهم،
ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم بغضاً للصحابة، وكذلك آل بيت الرسول
فلهم حق القرابة وحق الإيمان، ومذهب أهل السنة والجماعة: موالاة أهل بيت
النبي عليه الصلاة والسلام.
وأما النواصب: فيوالون الصحابة، ويبغضون بيت النبي عليه الصلاة
والسلام، ولذلك سموا بالنواصب؛ لنصبهم العداوة لأهل بيت النبي عليه
الصلاة والسلام.
والروافض: على العكس، والوا أهل البيت بزعمهم، وأبغضوا الصحابة،
ويلعنونهم ويكفرونهم ويذمونهم.
والصحابة يتفاضلون، فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة: أبو بكر وعمر
وعثمان وعلي، رضي الله عن الجميع، الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة
والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا
عليها بالنواجذ"( ) ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة وهم: أبو عبيدة عامر
بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، والزبير بن العوام، وطلحة بن
عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، رضي الله عنهم.
ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان، قال تعالى: (لقد رضي الله عن
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم
وأثابهم فتحاً قريباً) [الفتح:18].
ثم الذين آمنوا وجاهدوا قبل الفتح، فهم أفضل من الصحابة الذين آمنوا
وجاهدوا بعد الفتح، قال تعالى: (لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله
الحسنى) [الحديد:10] والمراد بالفتح: صلح الحديبية .
ثم المهاجرون عموماً، ثم الأنصار؛ لأن الله قدّم المهاجرين على
الأنصار في القرآن، قال سبحانه: (والسابقون الأولون من المهاجرين
والأنصار) [التوبة:100]، وقال سبحانه : (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله
أولئك هم الصادقون) [الحشر:8] وهؤلاء هم المهاجرون.
ثم قال سبحانه في الأنصار: (والذين تبوءو الدار والإيمان من قبلهم
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة زن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) [الحشر:9].
فقدّم المهاجرين وأعمالهم على الأنصار وأعمالهم، مما دل على أن
المهاجرين أفضل؛ لأنهم تركوا أوطانهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله، فدل
على صدق إيمانهم، فجميع الصحابة يجب حبهم وموالاتهم، ولا نتدخل فيما حصل
بينهم من حروب، فما حصل بينهم من الحروب فبتأويل منهم، فهم مجتهدون، فمن
أصاب منهم فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، وكذلك عندهم من الحسنات
والفضائل العظيمة التي تُكفِّر ما يقع من الخطأ من بعضهم.
فالواجب على المسلمين الترضّي عنهم، وطلب العذر لهم، والدفاع عنهم،
فمذهب أهل السنة والجماعة: أنهم لا يتدخلون فيما شجر بين الصحابة رضي
الله عنهم؛ لما لهم من الفضل والسابقة؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لا
تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد
أحدهم ولا نصيفه"( ) لفضلهم، فمن تدخل فيما حصل بين الصحابة وصار في قلبه
شيء، فهذا زنديق، فأما من قال: نتدخل فيما حصل بين الصحابة من باب البحث،
فهذا خطر عظيم ولا يجوز، ولذلك لما سُئل عمر بن عبد العزيز عما حصل بين
الصحابة قال: "أولئك قوم طهّر الله أيدينا من دمائهم، فيجب أن نطهر
ألسنتنا من أعراضهم".
وقال عليه الصلاة والسلام: "هل أنتم تاركو لي أصحابي؟"( ) فلا نتدخل
فيما حصل بين الصحابة؛ لأنه من مقتضى الإيمان ومن مقتضى النصيحة لله
ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم.
(195) ولا نفرط في حب أحد منهم:
الإفراط: الغلو، أي: لا نغلوا في حب أحد منهم، كما غلت الرافضة في حب
علي رضي الله عنه على زعمهم، وإلا الظاهر أنهم لا يحبونه ولا يحبون
المسلمين عموماً، فغلوا فيه حتى قال بعضهم: إن علياً هو الله، وذلك في
زمن علي رضي الله عنه، فخدَّ لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار غيرةً لله عز
وجل. فالغلو ممنوع سواء في الصحابة أو غيرهم، قال سبحانه : (يا أهل
الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق) [المائدة:77]، والنبي صلى الله عليه
وسلم يقول: "إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو"( ) فنحن نحب
أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لا نغلو فيهم حتى نجعلهم
شركاء لله وندعوهم من دون الله، كما تفعل الرافضة والقبوريون، فليس هذا
حباً للصحابة، فحبهم باتباعهم والاقتداء بهم والترضي عليهم.
(196) ولا نتبرأ من أحد منهم:
في هذا إشارة إلى الرافضة الذين يتبرؤون من الصحابة، وخاصة أبا بكر،
وعمر، وعثمان، بل يكفرون كثيراً من الصحابة، هذا من التفريط، فلا نُفرّط
في حبهم؛ لأن التفريط هو ترك محبتهم .
(197) ونبغض من يبغضهم:
من يبغض الصحابة فإنه يبغض الدين؛ لأنهم هم حملة الإسلام وأتباع
المصطفى عليه الصلاة والسلام، فمن أبغضهم فقد أبغض الإسلام؛ فهذا دليل
على أنه ليس في قلوب هؤلاء إيمان، وفيه دليل على أنهم لا يحبون الإسلام.
(198) وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير:
على ما سبق فلا يجوز الخوض فيما حصل بينهم؛ بل يجب الإمساك عن ذلك وأن
لا يُذكروا إلا بخير .
(199) وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان:
هذا أصل عظيم يجب على المسلمين معرفته، وهو محبة الصحابة وتقديرهم؛
لأن ذلك من الإيمان، بغضهم أو بغض أحد منهم من الكفر والنفاق، ولأن حبهم
من حب النبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهم من بغض النبي صلى الله عليه
وسلم.
(200) ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولاً لأبي
بكر الصديق رضي الله عنه، تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة، ثم لعمر
بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب
رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون:
لما فرغ مما يجب للصحابة من المحبة والولاء، وترك بغضهم وبغض من
يبغضهم، وعدم التدخل فيما جرى بينهم، شرع في ذكر الخلافة بعد النبي صلى
الله عليه وسلم، وهي على النحو الذي ذكره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
قدم أبا بكر للصلاة في آخر حياته، وفي هذا إشارة إلى خلافته، ولذلك قال
الصحابة لما بايعوه: (رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، ألا
نرضاك لدنيانا؟) فبايعوه، ولما لأبي بكر من السوابق العظيمة قبل الهجرة
وبعدها، وهو أولى الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عمر بن
الخطاب بعهد من أبي بكر، ثم عثمان بإجماع الصحابة باختيار من أصحاب
الشورى الذين عينهم عمر قبل وفاته من العشرة المبشرين بالجنة، وهم خيار
الصحابة. وبعد مقتل عثمان وليها علي رضي الله عنه، هذا هو ترتيب الخلافة،
فمن زعم أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه، فهو
ضال ومخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين.
فالشيعة: يزعمون أنها لعلي، ويسمونه الوصي على الأمة، وإنما قصدهم
التهويش وإشعال الفتن بين الناس، فهم ليسوا بأحسن نظراً من الصحابة رضي
الله عنهم. فالشيعة يقولون: الصحابة ظلمة، وكل وصف ذميم في القرآن المعني
به الصحابة عندهم فيصفونهم بأنهم ظالمون وكافرون وضالون، وهذا مما جعل
العلماء ينصون على ذكر الخلافة في كتب العقائد؛ لئلا يتأثر أحد بهؤلاء
الأرجاس. فترتيب الخلفاء الأربعة على هذا الترتيب هو مذهب أهل السنة
والجماعة؛ لأن الصحابة رتبوا هذا الترتيب وأجمعوا عليه، قال شيخ الإسلام
ابن تيمية: (من خالف في أمر الخلافة فهو أضل من حمار أهله) .
(201) وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم
بالجنة، على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوله
الحق، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد،
وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة، رضي الله
عنهم أجمعين:
فهؤلاء هم العشرة المشهود لهم بالجنة، وأبو عبيدة رضي الله عنه وصف
بأنه أمين هذه الأمة؛ لأنه لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم العهد مع
أهل نجران، وفرض عليهم الجزية، طلبوا منه أن يبعث إليهم أميناً، فاختار
أبا عبيدة وقال صلى الله عليه وسلم: "لأبعثن عليكم أميناً، حق أمين"
فاستشرف الصحابة لذلك فبعث أبا عبيدة( ).
(202) ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأزواجه
الطاهرات من كل دنس، وذرّيّاته المقدسين من كل رجس؛ فقد برئ من النفاق.
بعد أن ذكر ما يجب للصحابة انتقل إلى ذكر أهل بيت النبي صلى الله عليه
وسلم، وأول أهل البيت هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى:
(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً)
[الأحزاب:33]، هذا خطاب لهن.
فأول من يدخل في أهل البيت: زوجاته، ثم قرابته عليه الصلاة والسلام،
وهم آل العباس وآل أبي طالب، وآل الحارث بن عبد المطلب.
فالرافضة: يقدحون في عائشة ويصفونها بما برأها الله منه، وهذا تكذيب
لله عز وجل ووصف لله بأنه اختار لرسوله امرأة لا تصلح له، وهذا كفر
بالله، قال تعالى : (الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات
للطيبين والطيبون للطيبات) [النور:26] فالنبي صلى الله عليه وسلم طيب فلا
يختار الله له إلا الطيبة.
وذرياته المقصود بهم أولاده عليه الصلاة والسلام، وأولاد ابنته فاطمة،
وهم الحسن والحسين وأولادهما، هؤلاء ذريته صلى الله عليه وسلم .
(203) وعلماء السلف من السابقين، ومن بعدهم من التابعين –أهل الخير
والأثر، وأهل الفقه والنظر –لا يُذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو
على غير السبيل:
لما فرع –رحمه الله- من حقوق الصحابة وأهل البيت، وما يجب لهم من
المحبة والموالاة، وعدم التنقُّص لأحد منهم انتقل إلى الذين يلونهم في
الفضيلة وهم العلماء، فعلماء هذه الأمة لهم منـزلة وفضل بعد الصحابة؛
لأنهم ورثة الأنبياء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "العلماء ورثة
الأنبياء"( ) والمراد بهم : علماء أهل السنة والجماعة، أهل العلم والنظر
والفقه، وأهل الأثر، وهم أهل الحديث.
فالعلماء على قسمين:
القسم الأول: علماء الأثر، وهم المحدثون الذين اعتنوا بسنة النبي صلى
الله عليه وسلم وحفظوها وذبُّوا عنها، وقدموها للأمة صافية نقية، كما نطق
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعدوا عنها كل دخيل وكل كذب، فنحوا
الأحاديث الموضوعة وبينوها وحاصروها، فهؤلاء يسمون: علماء الرواية.
القسم الثاني : وهم الفقهاء، وهم الذين استنبطوا الأحكام، من هذه
الأدلة، وبينوا فقهها، وشرحوها وبينوها للناس، فهؤلاء يسمون: علماء
الدراية.
ومنهم من جمع بين العلمين، ويسمون: فقهاء المحدثين، كالإمام أحمد،
ومالك، والشافعي، والبخاري.
وكل هؤلاء العلماء لهم فضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "نضّر
الله أمرأً سمع مقالتي فوعاها فأدّاها كما سمعها"( ) فالنبي صلى الله
عليه وسلم دعا لهم ومدحهم.
فالعلماء قاموا بما أوجب الله عليهم من حماية الدين والعقيدة، فبينوا
الأحكام، والمواريث، والحلال والحرام، وبينوا أيضاً فقه الكتاب والسنة،
فجعلوا للأمة ثروة عظيمة يستفاد منها ويقاس عليها ما يجد من مشاكل.
والفقه على قسمين:
القسم الأول: الفقه الأكبر، وهو فقه العقيدة.
القسم الثاني: وهو فقه عملي، لا يقل عن الفقه الأكبر من حيث الأهمية،
وهو فقه الأحكام العملية.
وفي فضل العلماء جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "فضل
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب"( ) وذلك لأن نفعهم
يتعدّى، وفي رواية: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم"( )
فالعلماء لهم احترام ومنـزلة.
فلا يجوز الطعن فيهم وتنقصهم حتى لو حصل من بعضهم خطأ في الاجتهاد،
فهذا لا يقتضي تنقصهم؛ لأنهم قد يخطئون، ومع ذلك هم طالبون للحق، قال
النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا
اجتهد فأخطأ فله أجر واحد"( ) وهذا في حق العلماء وليس المتعالمين؛ لأنه
لا يحق لهم أن يدخلوا فيما لا يحسنون .
(204) ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام،
ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء:
انتقل المصنف –رحمه الله- من العلماء إلى الأولياء.
والأولياء: جمع ولي، والولاية هي القرب والمحبة، فهم أهل القرب
والمحبة من الله عز وجل، وسُمُّوا بالأولياء لقربهم من الله، ولأن الله
يحبهم، قال تعالى : (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) [البقرة:222]
وقال تعالى: (إن الله يحب المحسنين) [البقرة:195].
وقد بينهم الله في قوله: (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم
يحزنون* الذين آمنوا وكانوا يتقون) [يونس:62،63]، فالولي لابد أن يجتمع
فيه صفتان:
الأولى: الإيمان.
والثانية: التقوى.
والناس في الولاية والبغض على أقسام ثلاثة:
القسم الأول: أولياء الله الخُلَّص من الملائكة والنبيين والصدّيقين
والشهداء وصالح المؤمنين.
القسم الثاني: أعداء لله عداوة خالصة، كالمشرك والكافر والمنافق
النفاق الأكبر، فهؤلاء أعداء الله ورسوله (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق)
[الممتحنة:1]، وقال تعالى : (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو
عشيرتهم) [المجادلة:22]، وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن
الله لا يهدي القوم الظالمين) [المائدة:51].
القسم الثالث: من فيهم ولاية من وجه، وعداوة من وجه، وهو المسلم
العاصي، ففيه ولاية بقدر ما معه من طاعة، وفيه عداوة بقدر ما معه من
معصية، فكل مسلم ولي لله ولكن على حسب ما معه من إيمان.
فمن ادّعى الولاية أو ادعيت له الولاية وليس معه إيمان، وليس فيه
تقوى، فإنما هو دجال وكذاب.
وقد يدعون الولاية وهم سحرة وكهنة ومشعوذون وعرافون، وقد كتب شيخ
الإسلام كتاباً سمّاه (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) وبيّن
فيه من يدّعي الولاية، ويُروج على الناس أشياءً يظن أنها كرامات، وهي
خوارق شيطانية، وسيأتي بيانه.
فتجب محبة أولياء الله، والاقتداء بهم، وولايتهم، والقرب منهم.
وقوله : (ولا نفضل أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم
السلام):
رد على الصوفية، فعندهم غلو في الأولياء. وأنهم عندهم أفضل من
الأنبياء وأهل السنة والجماعة لا يغلون في الأولياء وينـزلونهم منازلهم،
أما الصوفية الضلال فيفضلونهم على الأنبياء، يقول قائلهم:
مقــام النبوة في منــزل فويـق الرسـول ودون الولـي
وهذا كفر؛ لأن الأفضل الرسل ثم الأنبياء ثم الأولياء، وسبب تقديم
الولي على النبي عند الصوفية –على زعمهم- أن الولي يأخذ عن الله مباشرة،
والنبي يأخذ بواسطة.
وقوله: (ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء) :
وهذا لا شك فيه، فجميع الأولياء من أول الخلق إلى آخرهم لا يعادلون
نبياً واحداً، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة.
(205) ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصح عن الثقات من رواياتهم :
هذا بحث عظيم، وهو بحث الكرامات، فالكرامة هي الخارق للعادة، فإن كانت
على يد نبي فهي معجزة، مثل معجزة القرآن، فالإنس والجن عجزوا عن أن يأتوا
بمثله، وهي أعظم المعجزات، ومثل معجزة عصا موسى، والتسع الآيات، ومثل
إحياء الموتى لعيسى ابن مريم؛ وإن جرت الخارقة على يد رجل صالح فهو كرامة
من الله أجراها على يده، وليس من عنده، مثل ما حصل لأصحاب الكهف وما حصل
لمريم (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً) [آل عمران:37]
فكان يأتيها رزقها وهي تتعبّد الله ولم تخرج من المحراب، وكذلك ما حصل من
كرامات لهذه الأمة، وقد ذكر شيخ الإسلام طرفاً منها في كتابه: الفرقان.
أما إذا جرى الخارق على يد كاهن أو ساحر فهذا خارق شيطاني، يجري على
يده من أجل الابتلاء والامتحان، فقد يطير في الهواء ويمشي على الماء
ويعمل أعمالاً خارقة للعادة وهي من أعمال الشياطين.
والضابط: أننا ننظر إلى عمله، فإن كان موافقاً للإسلام، فما يجري على
يده كرامة، وإلا فهو من خدمة الشياطين له.
قال تعالى: (ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض) [الأنعام:128]، فالجني
استمتع بالإنسي بالخضوع له وطاعته، والإنسي استمتع بالجني لأنه يخدمه
ويحضر له ما يريد، قال تعالى: (قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء
الله إن ربك حكيم عليم* وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون)
[الأنعام:128،129]، فهذه خوارق شيطانية، فالفارق بينها وبين الكرامة:
الإيمان والعمل الصالح؛ وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أما من عاداهم
فقد حصل عنده بسبب فهم الخوارق خلط كثير، فالمعتزلة ومن نحا نحوهم من
العقلانيين إلى يومنا هذا ينكرون الكرامات، حتى إن غلاتهم ينكرون بعض
المعجزات، ويقولون: هذه لا يثبتها العقل؛ لأنهم يقدمون عقولهم.
الصنف الثاني: وهم القبوريون والصوفيون، غلوا في إثبات الكرامات حتى
أثبتوها لأولياء الشيطان، فيثبتونها لمن لا يصلي ولا يصوم إذا جرى على
يده خارق للعادة، وهي خوارق شيطانية، ومنهم من يغلو في الولي الصالح
ويتخذه إلهاً مع الله كما حدث للقبوريين، فلو قرأت كتاب الشعراني المسمى
"طبقات الأولياء" لرأيت العجب العجاب والحكايات الباطلة، فالولي عندهم
خرج عن التكاليف ولا يحتاج إلى العبادة.
فالإنسان مهما بلغ من الصلاح والعبادة فإنه لا يخرج عن العبودية، لا
الملائكة، ولا الأولياء، ولا الأنبياء، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم
يقول: "والله إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأتقاكم" ، وهو سيد البشر
وخير من مشى على الأرض، ويقول الله له: (واعبد ربك حتى يأتيك اليقين)
[الحجر:99] فما أحد بلغ ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم وما خرج عن
عبادة الله، حتى المسيح صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل فيه: (لن
يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن
عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً* فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات
فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم
عذاباً أليماً ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً)
[النساء:172،173] فهذا بحث عظيم يجب معرفته، وبخاصة في أوقات الجهل
والخرافة.
(206) ونؤمن بأشراط الساعة: من خروج الدجال:
الأشراط: جمع شرط، وهو العلامة، ومنه سمي الشرطي: شرطياً؛ لوجود
العلامة عليه.
وأشراط الساعة: علاماتها الدالة على قرب وقوعها، قال سبحانة: (فهل
ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها) [محمد:18] فقوله:
(فهل ينظرون) أي: ينتظرون، وقوله: (بغتة) أي: لا يعلم وقتها إلا الله،
قال سبحانه: (ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة) [الأعراف:187]،
وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: "أخبرني عن الساعة، قال: ما
المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها، قال: "إن تلد
الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان"( )
.
وقد ذكر العلماء أن أشراط الساعة على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: العلامات الصغرى، وهذه حصلت وانقضت.
القسم الثاني: العلامات الوسطى، هذه ما تزال تحدث مثل ما حدث في
زماننا من تقدم الصناعات والاتصالات، واستخراج الكنوز من الأرض، وتقارب
البلدان، حتى كأن العالم قرية واحدة، واجتماع اليهود في فلسطين انتظاراً
للدجال، وتوطئة للملاحم التي ستقوم هناك.
القسم الثالث: العلامات الكبرى، من خروج الدجال، ونزول عيسى عليه
الصلاة والسلام، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، ثم طلوع الشمس من
مغربها، فهذه إذا حصل أحدها تتابعت البقية.
وقوله: (من خروج الدجال) :
هو أول العلامات الكبرى، وهو من اليهود، ويدّعي الربوبية، ومعه خوارق
شيطانية، تفتن الناس، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتخرج ما فيها من
الكنوز والنبات.
والدجّال هو أشد الفتن؛ لأن الذين يفتنون به كثير؛ لشدة ما معه من
الفتن، ومعه جنة ونار، ويأتي على جميع الأرض إلا مكة والمدينة، وهذه
الفتنة تميز المؤمن من الكافر، وسُمّي دجالاً من الدجل، وهو الكذب؛ لكثرة
كذبه، وسمي المسيح؛ لأنه يسير في الأرض ويمسحها بسرعة؛ لما هيأ الله له
من وسائل المواصلات السريعة، التي هي أسرع من الريح، وقيل: سمي بذلك لأن
عينه ممسوحة، فهو أعور، ويسمى: مسيح الضلالة. فيخرج الدجال فيتبعه
اليهود، فيقودهم، ويحصل بسببه على المسلمين فتنة عظيمة، وما من نبي إلا
حذر أمته منه، وأشدهم تحذيراً منه نبينا صلى الله عليه وسلم؛ لأنه آخر
الأنبياء، وأمته آخر الأمم، وأقربها للدجال، وأمرنا النبي صلى الله عليه
وسلم بعد التشهد الأخير من الصلاة: "أن نتعوذ بالله من أربع: من عذاب
جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح
الدجال"( ) فهو فتنة عظيمة وشر كبير، فينـزل عيسى عليه الصلاة والسلام من
السماء فيقتله بباب "لد" فيريح الله منه المسلمين، ثم يحكم عيسى بحكم
الإسلام، فهو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ليس بعد نبينا نبي،
وليس بعد شريعة الإسلام شريعة.
ثم يخرج في وقته يأجوج ومأجوج، وهم أيضاً فتنة عظيمة، قال تعالى: (حتى
إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون) [الأنبياء:96]، وهم أمة من
الأمم من بني آدم، كانوا في زمان الإسكندر ذي القرنين، وبنى دونهم السد،
قال الله تعالى: (فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً)
[الكهف:97] فلا يستطيعون الصعود فوق الحائط، ولا يستطيعون نقبة؛ لقوته؛
لأنه من الحديد والبأس الشديد، ولكن إذا جاء وعد الله جعله دكاً، فيخرجون
ويفتكون بالعالم، وليس لأحد طاقة في قتالهم، ثم يهلكهم الله في ساعة
واحدة.
(207) ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء:
ويسمى بالمسيح؛ لأنه كان يمسح على ذي العاهة فيشفيه الله، ويسمى: مسيح
الهداية، ونزوله من السماء إلى الأرض في آخر الزمان متواتر، ومن أنكر ذلك
فهو كافر، قال تعالى : (وإنه لعلم للساعة) [الزخرف:61] وفي قراءة: (وإنه
لعلم للساعة) –بفتح العين واللام- أي: علامة على قرب الساعة، قال الله
سبحانه: (وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته) [النساء:159] وهذا
في آخر الزمان؛ لأنه حي في السماء ولا يموت إلا بعد إنهاء المهمة الموكلة
إليه، فيموت فيدفن في الأرض بعد أن يقتل الدجال والخنـزير ويضع الجزية
ويحكم بالإسلام.
(208) ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها:
الشمس مسخرة تجري بأمر الله، فتخرج من المشرق، وتغرب من المغرب، ثم
إذا كان آخر الزمان وحان قيام الساعة أمرها الله سبحانه بالطلوع من
المغرب، فتكون علامة للقيامة، وإذا طلعت من مغربها فلا يقبل الله توبة
التائب، قال سبحانه: (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو
يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون)
[الأنعام:158] فالكافر يسلم، ولكن لا يقبل الله إسلامه، والعاصي يتوب،
ولكن لا تقبل توبته.
(209) وخروج دابة الأرض من موضعها:
قال سبحانه: (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم
أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) [النمل:82] تخرج هذه الدابة فتسم
المؤمن والكافر، أي: تضع عليه علامة يتعارف الناس بها، فيتخاطبون، وهذا
يقول: يا مسلم، وهذا يقول: يا كافر، ومعنى قول الله : (تكلمهم) بكلام
خارق للعادة. وليس عندنا خبر ثابت عن موضع خروجها، لكن نؤمن بخروجها من
موضعها الذي يعلمه عالم الغيب والشهادة، قال سبحانه: (أخرجنا لهم دابة من
الأرض تكلمهم) [النمل:82].
(210) ولا نصدق كاهناً ولا عرّافاً:
سبق أن ذكر المؤلف الكرامات وضابطها، وأن الكرامات حق ثابت، ولا يجوز
الاعتماد عليها، ولا يظن بأن للأولياء مرتبة يُدعون فيها مع الله عز وجل،
كما يقوله القبوريون والخرافيون، فيتعلقون بالأولياء والصالحين من أهل
هذه الخوارق.
أما قوله رحمه الله: (لا نصدق كاهناً ولا عرافاً) ففيه بيان الفرق بين
الكرامة والكهانة والعرافة والسحر والشعوذة والتنجيم، فهذه –أي التي مع
الكهان والعرافين- خوارق شيطانية وأعمال حذقوها وتعلموها بسبب تقربهم من
الشياطين فيظن الناس والجهال أن هذه كرامات وأنها بسبب ولا يتهم لله،
وهذا غلط، إنما هي من فعل الشياطين؛ لخضوعهم لهم وموافقتهم على الشرك،
فالسحرة ما توصلوا إلى السحر إلا لخضوعهم للشياطين، فالسحر من عمل
الشيطان وهو كفر بالله، فلا يغتر بهم، فهم يقولون: هذه كرامة أو أعمال
رياضية أو أعمال بهلوانية، ويحضرون في المحافل والنوادي، ويتركون يعملون
السحر أمام الناس، ويقولون: هذه أمور رياضية، ليضلوا الناس وليأكلوا
بسحرهم الأموال، فيجب التنبيه على هؤلاء وبغضهم وعداوتهم؛ لأنهم أعداء
الله ولرسوله.
والسحر على قسمين :
القسم الأول: سحر حقيقي : وهو ما يؤثر في بدن المسحور فيمرضه أو يؤثر
على عقله أو يقتله، فهذا عمل شيطاني.
القسم الثاني: سحر تخييلي، قال الله تعالى: (يخيل إليه من سحرهم أنها
تسعى) [طه:66] وهو ما يسمى: القمرة، فيعملون شيئاً على أعين الناس، وهو
ليس له حقيقة، فيظهر منه أن يضرب نفسه بالسيف، وأنه يأكل المسامير أو
النار أو الزجاج، أو يدخل في النار، أو أن السيارة تمشي عليه، أو ينام
على مسامير، أو يجر السيارة بشعره، أو يأتي بأوراق عادية، ويروج على
الناس أنها نقود، وإذا ذهب سرحه عادت الأوراق إلى أصلها، كما يحصل من
النشالين. ومن أعمال السحرة أيضاً: أن يأتي أحدهم بجعلٍ، وهي الحشرة
المعروفة، ويُظهر بسحره أمام الناس أنها خروف، وكذلك فهم يروجون على
الناس أنهم يمشون على خيط دقيق، وهو ما يسمى السرك، أو ما يسمى
بالبهلوان.
فهذا كله كذب وتدجيل على الناس، وسحر لأعين الناس، وهو سحر تخييلي،
إذا ذهب هذا السحر عادت الأمور كما هي، فيجب علينا أن لا نغتر بهم ولا
نصدقهم ولا نمكنهم من أولادنا ولا بلادنا من أجل ترويج سحرهم.
وأما الكاهن: فهو الذي يدعي علم الغيب وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه
وسلم أن الشياطين يسترقون السمع فيسرقون الكلمة، فيخبرون بها الكاهن
فيكذب معها مائة كذبة فيصدقه الناس في كل ما قال بسبب تلك الكلمة، قال
سبحانه: (هل أنبئكم على من تنـزل الشياطين* تنـزل على كل أفاك أثيم*
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون) [الشعراء:221،223] وكانت الكهانة في
الجاهلية كثيرة، فكان في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الأمور
الغائبة، ولما جاء الإسلام أبطل الكهانة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم
من الذهاب إلى الكهان، قال عليه الصلاة والسلام: "من أتى كاهناً لم يقبل
منه صلاة أربعين يوماً"( ) وهذا الحديث في صحيح مسلم.
وجاء في السنن "من أتى كاهناً أو عرافاً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما
أنزل على محمد"( ) ، ولما سُئل عن الكهان قال: "ليسوا بشيء"، وقال النبي
صلى الله عليه وسلم: "لا تأتوهم"
فالكاهن: هو الذي يدّعي علم الغيب، بسبب تعامله مع الشيطان.
وأما العراف : فهو الذي يدّعي علم الغيب، لكن ليس بواسطة الشياطين،
وإنما بالحدس والتخمين، فيقول: يمكن أن يقع كذا وكذا، بناء على تنبؤات
كاذبة.
وقال بعض أهل العلم: إن العراف هو الكاهن، كل منهما يخبر عن الأمور
الغائبة لكن باختلاف الوسيلة، فيجب على المسلم أن يكفر بالكهانة
والعرافة، ولا يصدق أهلها، فهم ليسوا من أولياء الله، إنما هم من أولياء
الشيطان، ومن أراد التوسع في هذا فليراجع كتاب "الفرقان" لشيخ الإسلام.
وأما التنجيم فالمنجم: هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة بواسطة النظر
في النجوم، إذا طلع النجم الفلاني يحصل كذا، وإذا غرب النجم الفلاني يحصل
كذا، والبرج الفلاني فيه نحس أو فيه سعادة، وهكذا يستندون إلى هذه
الأعمال الكاذبة.
فالتنجيم: (هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية) كما عرفه
شيخ الإسلام. والتنجيم من أمور الجاهلية، قال عليه الصلاة والسلام: "أربع
في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر
بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم"( )، أي: طلب السقاية
من النجوم، قال سبحانه وتعالى: (فلا أقسم بمواقع النجوم* وإنه لقسم لو
تعلمون عظيم* إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون*
تنـزيل من رب العالمين* أفبهذا الحديث أنتم مدهنون* وتجعلون رزقكم أنكم
تكذبون) [الواقعة:75،82]، أي : تنسبون ما يحصل لكم من الرزق للنجوم
والحوادث الفلكية، فهذا من اعتقاد الجاهلية، فالنجوم إنما هي خلق من خلق
الله مسخرة، وخلقها الله لثلاث حكم:
الأولى: أنها زينة للسماء الدنيا.
الثانية: أنها رجوم للشياطين.
الثالثة: أنها علامات يهتدي بها في ظلمات البر والبحر، فمن اعتقد أنها
لغير ذلك فهو قد أضاع نصيبه.
وإذا تدبرت القرآن وجدت أن الله ذكر للنجوم ثلاث فوائد، أما ما يحدث
في الأرض من حوادث فليس للنجوم فيها تأثير، وإنما المنجمون يُدَلسون
ويكذبون على الناس، ويقولون: إن هذه الحوادث بسبب النجوم، قال سبحانه:
(والنجوم مسخرات بأمره) [النحل:12]، فهذه الأمور تخل بالعقيدة، ويبطل
إيمانه إذا صدق أن النجوم هي التي فعلت هذا الشيء بالكون.
(211) ولا من يدعي شيئاً يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة:
أي: لا نصدق أحداً يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع؛ لأنها الأدلة
التي يعتمد عليها، فما خالفها فهو باطل، سواء من الأقوال أو الأعمال أو
الاعتقادات.
(212) ونرى الجماعة حقاً وصواباً، والفرقة زيغاً وعذاباً:
نرى –معشر أهل السنة والجماعة- أن الاجتماع حق والفرقة عذاب،
فالاجتماع للأمة على الحق رحمة، والفرقة بينهما عذاب، وهذا من صميم عقيدة
أهل السنة والجماعة، فيجب الاجتماع ونبذ الفرقة، قال سبحانه وتعالى:
(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا) [آل عمران:103]، فحبل الله
القرآن والإسلام، وقوله: (جميعاً) أي: اجتمعوا على القرآن والسنة، وقوله:
(ولا تفرقوا) لما أمر الله بالاجتماع نهى عن الفرقة، وأخبر أن الاجتماع
يكون على حبل الله، وهو القرآن، ولا يجوز الاجتماع على غيره من المذاهب
والحزبيات، فهذا يُسبب الفرقة.
فالاجتماع لا يحصل إلا على كتاب الله، قال سبحانه: (واعتصموا بحبل
الله جميعاً ولا تفرقوا) [آل عمران:103].
فأمر الله سبحانه بالاجتماع ونبذ الفرقة في الآراء وفي القلوب،
فالمسلمون مهما تفرقوا وبعدت أقطارهم فإنّهم مجتمعون على الحق، وقلوبهم
مجتمعة، ويحب بعضهم بعضاً، أما أهل الباطل وإن كانوا في مكان واحد، أحدهم
إلى جنب الآخر، فهم مجتمعة أبدانهم متفرقة قلوبهم، قال سبحانه: (تحسبهم
جميعاً وقلوبهم شتى) وقال تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من
بعدما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) [آل عمران:105]، وقال سبحانه:
(ولا تكونوا من المشركين* من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما
لديهم فرحون) [الروم:31،32]، وقال سبحانه: (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا
فيه) [الشورى:13].
فالواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة في عقيدتها وفي عبادتها وفي
جماعتها وطاعتها لولي أمرها، فتكون يداً واحدة، وجسماً واحداً، وبنياناً
واحداً، كما شبهها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا رحمة للمسلمين، تُحقن
دماؤهم، وتتآلف قلوبهم، ويأمن مجتمعهم، فإذا حصل هذا درت عليهم الأرزاق.
أما إذا تناحروا وتقاطعوا وتباغضوا تسلط عليهم الأعداء، وسفك بعضهم دماء
بعض.
والاختلاف على قسمين:
القسم الأول: اختلاف في العقيدة، وهذا لا يجوز أبداً؛ لأنه يوجب
التناحر والعداوة والبغضاء ويفرق الكلمة، فيجب أن يكون المسلمون على
عقيدة واحدة، وهي عقيدة لا إله إلا الله، واعتقاد ذلك قولاً وعملاً
واعتقاداً، والعقيدة توقيفية ليست محلاً للاجتهاد، فإذا كانت كذلك فليس
فيها مجال للتفرق، فالعقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة، لا من الآراء
والاجتهادات، فالفرقة في العقيدة تؤدّي إلى التناحر والتباغض والتقاطع،
كما حصل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفرق الضالة التي أخبر عنها
النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين
فرقة، كلها في النار إلا واحدة" قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: "من كان
على مثل ما أنا عليه وأصحابي"( ) فما يجمع الناس إلا ما كان مثل ما عليه
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
القسم الثاني: اختلاف في الاجتهاد الفقهي، وهذا لا يوجب عداوة؛ لأن
سببه هو النظر في الأدلة حسب مدارك الناس، والناس يختلفون في ذلك، وليسوا
على حد سواء، فهم يختلفون في قوة الاستنباط وفي كثرة العلم وقلته.
فهذا الخلاف إذا لم يصحبه تعصب للرأي فإنه لا يفضي إلى العداوة، وكان
الصحابة يختلفون في المسائل الفقهية، ولا يحدث بينهم عداوة، وهم إخوة،
وكذلك السلف الصالح والأئمة الأربعة يختلفون، ولم يحصل بينهم عداوة، وهم
إخوة، وكذلك أتباعهم، فإذا تعصب أحدهم للرأي فإن ذلك يوجب العداوة، ويجب
على المسلم أن يأخذ الأقوال التي توافق الدليل من الكتاب أو السنة، قال
سبحانه: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله
واليوم الآخر) [النساء:59]، وقال سبحانه: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه
إلى الله) [الشورى:10] فيرجع في الخلاف إلى الكتاب والسنة ويؤخذ ما ترجح
بالدليل .
(213) ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام:
والإسلام عبادة الله وحده لا شريك له، فهذا تدين به الملائكة في
السماء والإنس والجن في الأرض، وهو دين الإسلام، ومعناه بمفهومه العام:
هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، كما
عرفه شيخ الإسلام ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الثلاثة الأصول،
فالإسلام دين جميع الأنبياء وأتباعهم، فكل نبي دعا قومه إلى ذلك، وكل من
اتبعه على ذلك فيعتبر مسلماً، سواء من أول الخلق أو آخرهم، فهو مستسلم
لله بالتوحيد ومنقاد إلى الله بالطاعة، فدين الأنبياء واحد، وشرائعهم شتى
ومختلفة بسبب حاجة البشر في كل زمان ومكان، ففي الحديث: "الأنبياء إخوة
لعلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد"( ) وقال تعالى: (لكل جعلنا منكم شرعة
ومنهاجاً) [المائدة:48]، فالله يشرع لكل نبي ما يناسب قومه ويناسب
مصالحهم، ثم ينسخ الله لأمة أخرى بحسب مصالحها، فمن كان على دين نبي قبل
أن ينسخ فهو مسلم، فعبادة الله بما شرعه لذلك النبي، ولكن بعد البعثة
المحمدية صار الدين واحداً ونسخ الله ما قبله، وصار الدين المعتبر دينه
عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يبقى على دين من الأديان السابقة؛
لأن رسالته ودينه عليه الصلاة والسلام عام لكل الخلق، وشامل لكل زمان
ولكل جيل.
(214) قال الله تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام) . وقال تعالى :
(ورضيت لكم الإسلام ديناً):
فهو الدين الذي رضيه لعباده من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن
تقوم الساعة.
(215) وهو بين الغلو والتقصير:
فالإسلام وسط بين الغلو، وهو: الزيادة والتشديد، وبين التقصير، وهو:
الجفاء، فدين الإسلام وسط لا تشديد فيه ولا تحلل منه، فكلا الطرفين
مذموم، والوسط خير، ولهذا قال سبحانه: (يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم
غير الحق) [المائدة:77] وقال عليه الصلاة والسلام: "هلك المتنطعون" قالها
ثلاثاً( )، والمتنطعون هم المتشددون في أمور الدين، ولما قال نفر على عهد
النبي صلى الله عليه وسلم.. قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر:
أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال
الرابع: أما أنا فاعتزل النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: "أما إني
أتقاكم لله وأخشاكم لله، وإني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء،
وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني"( )؛ لأن هذا تشديد ما أمر الله
به، قال سبحانه: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)
[المائدة:87] يعني : من باب التدين، وقال سبحانه : (ولا تعتدوا)
[المائدة:87] فالآية شملت الطرفين، فالدين وسط.
(216) وبين التشبيه والتعطيل:
أي : في العقيدة، بين التعطيل والتشبيه، بين تعطيل أسماء الله وصفاته،
وبين تشبيه المخلوق بالخالق، والعقيدة وسط، فالمعطلة غلوا في التنـزيه،
فنفوا الأسماء والصفات، والمشبهة غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه،
والعقيدة، وسط، قال سبحانه: (ليس كمثله شيء) [الشورى:11] هذا رد على
المشبهة، (وهو السميع البصير) [الشورى:11] هذا فيه رد على المعطلة، -ونحن
معشر أهل السنة والجماعة- نثبت ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله،
من الأسماء والصفات، ولا نعطلها ولا ننفيها، ولا نشبه الله بأحد من خلقه،
بل: نقول أسماء الله وصفاته تليق به سبحانه وإن كانت هذه الأسماء والصفات
موجودة في البشر، لكن الكيفية مختلفة، والصفة تابعة للموصوف.
(217) وبين الجبر والقدر:
مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية، فالجبرية يغلون في
إثبات القدر حتى يسلبوا العبد عن الاختيار، فيقولون: العبد ليس له
اختيار، أفعاله كلها مجبور عليها، فهو آلة يحركه القدر، فصلاته وصيامه
وأعماله ليس له فيها اختيار، فهو يحرك كما تحرك الآلة، وهذا مذهب باطل.
والقدرية غلوا في إثبات اختيار العبد فنفوا القدر، حتى جعلوا العبد يستقل
بأفعاله ويخرجونها من إرادة الله ومشيئته، وأن العبد له إرادة مستقلة،
فقالوا: هو الذي يخلق فعل نفسه، وليس لله فيها تصرف، وهذا مذهب المعتزلة.
أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا في هذه المسألة، وقالوا: إن العبد له
اختيار ومشيئة، يفعل باختياره، ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره،
فأفعاله خلق الله، وهي فعله وكسبه، فهو الذي يفعل المعاصي ويفعل الطاعات،
ولكن الله هو المقدر، فلذلك يعاقب على جرائمه، ويثاب على طاعته، ولو كان
يفعل هذا بغير اختياره ما حصل على الثواب ولا العقاب، فالمجنون والصغير
لا يؤاخذان، وكذلك المكره الذي ليس له اختيار لا يؤاخذ .
(218) وبين الأمن والإياس :
كذلك، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الوسط بين الأمن من مكر
الله والإياس من رحمته، فهم يرجون رحمة الله، ولا يأمنون من مكر الله،
ولا من العذاب والفتنة، لكن لا يقنطون من رحمة الله، فيجمعون بين الخوف
والرجاء، وهو ما كان عليه الأنبياء، قال سبحانه: (إنهم كانوا يسارعون في
الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين) [الأنبياء:90]، فهؤلاء
هم الأنبياء، فخوفهم من الله لم يحملهم على القنوط من رحمة الله، قال
سبحانه: (إنه لا يأيئس من روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف:87]، وقال
سبحانه: (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) [الحجر:56]، وأيضاً: رجاؤهم
من الله لم يحملهم على الأمن من مكر الله، قال سبحانه: (أفأمنوا مكر الله
فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) [الأعراف:99].
فإبراهيم أبو الأنبياء يقول: (واجنبني وبني أن نعبد الأصنام)
[إبراهيم:35] فإبراهيم ما أمن على نفسه، ولكنه خاف الفتنة؛ لأنه بشر.
فلا يأمن الإنسان على نفسه ويقول: أنا رجل صالح، بل يخاف على نفسه، مع
عدم القنوط من رحمة الله، قال تعالى: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور
الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له) [الزمر:53،54].
فالواجب على الإنسان: أن يفعل أسباب الرحمة، وهي التوبة وإسلام الوجه
لله سبحانه، عند ذلك يحصل على رحمة الله، فرحمة الله قريب من المحسنين،
والإحسان سبب الرحمة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو بين مذهب المرجئة
الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، فإذا كان الإنسان مؤمناً بقلبه
فلا تضره المعصية، فهؤلاء أمنوا مكر الله، ويقولون: الأعمال لا تدخل في
حقيقة الإيمان، فيدخل الجنة وإن لم يعمل شيئاً عندهم، وهذا مذهب أفسد
الدنيا، تحلل الناس من الدين بسببه، وقالوا: ما دام أننا ندخل الجنة، فلا
حاجة إلى الأعمال، فيفعلون ما يشاءون.
وبين الوعيدية الخوارج الذين يُكفِّرون بالكبائر التي دون الشرك،
ويرون إنفاذ الوعيد الذي ذكره الله على من عصاه، فإن الله توعد العصاة،
لكن قال: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)
[النساء:48]. فهم تحت المشيئة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الوسط.
والقول الحق مع أهل السنة والجماعة الذين توسطوا بين الأمن والرجاء،
والخوف والقنوط، ولهذا يقولون: الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي
الطائرة، ولابد من سلامة الجناحين، فكذلك الخوف والرجاء لو اختل أحدهما
سقط، فلابد من التعادل كما يتعادل جناحا الطائر.
(219) فهذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً. ونحن براء إلى الله من كل
من خالف الذي ذكرناه وبيناه:
أي: ما ذكرناه في هذه العقيدة من أولـها إلى آخرها، فهو ديننا معشر
المسلمين، ونحن براء من كل من خالفه؛ لأنها عقيدة حق، وما خالفها فهو
باطل.
(220) ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا به:
هذا تأدب مع الله، لما بين عقيدة أهل السنة والجماعة، سأل الله أن
يثبته عليها، فلا يكفي أن الإنسان يعرف العقيدة، فالعالم يَزَلُّ ويخطئ،
فلا يغتر الإنسان بعلمه، ولا يأمن الفتن، فهل علمه يعادل علم إبراهيم
عليه الصلاة والسلام؟ وقد دعاء الله فقال: (واجنبني وبني أن نعبد
الأصنام* رب أنهن أضللن كثيراً من الناس) [النساء:35،36].
فالإنسان يسأل الله السلامة والعافية، فكم من عالم زل وانحرف عن
الدين، وكم وكم.. فالأعمال بالخواتيم.
(221) ويعصمنا من الأهواء المختلفة، والآراء المتفرقة:
ما أضل الناس إلا الأهواء، قال تعالى: (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير
هدى من الله) [القصص:50]، وقال سبحانه: (أفرءيت من اتخذ إلهه هواه وأضله
الله على علم) [الجاثية:23] فالإنسان يسأل الله السلامة من الهوى، وأن
يهديه الحق، وإن خالف هواه، وقال الله عز وجل في اليهود: (أفكلما جاءكم
رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون)
[البقرة:87]، فالهوى خطير جداً.
(222) والمذاهب الردية:
وهي الفرق التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام بقوله: "ستفترق هذه
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار…."( ) الحديث؛ لأنها خارجه عن
الحق، إلا من سار على مثل ما سار عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام
وأصحابه، فإنهم ناجون من النار، ولذلك سموا بالفرقة الناجية.
والمذاهب بمعنى الآراء.
(223) مثل المشبهة:
هم الذين شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين.
(224) والمعتزلة:
هم الذين عطلوا صفات الله ونفوها، بحجة أنهم ينـزهون الله، فغلوا في
التنـزيه، وهم أتباع واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وكانا من تلاميذ الحسن
البصري، وكانوا يحضرون في حلقته، فسئل الحسن البصري عن صاحب الكبيرة،
فأجاب بما يوافق الكتاب والسنة، وقال: هو تحت المشيئة، ولا يكفر
بالكبيرة، وهو ناقص الإيمان، فعند ذلك أنكر عليه واصل وقال له: هو في
منـزلة بين المنـزلتين، ليس بكافر ولا مسلم. فاخترع هذا المذهب الباطل،
واعتزل مجلس الحسن، واجتمع حوله الناس الذين هم من جنسه، فكونوا جماعة
سُمُّو بالمعتزلة.
(225) والجهمية والجبرية:
وهم أتباع الجهم بن صفوان( ) الترمذي، تبنّى مذهب شيخه الجعد بن درهم(
)، وهذا أخذه عن طالوت اليهودي، الذي أخذه عن لبيد بن الأعصم الذي سحر
النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المذهب هو القول بخلق القرآن، ومن
أقوالهم: الجبر؛ أن الإنسان مجبور على أعماله وغيرها، ولذلك نُسبوا إلى
الجهم، وسموا بالجهمية، فالجهم أخذه من الجعد الذي كان في أواخر دولة بني
أمية، وقتله خالد بن عبد الله القسري، كان خالد يخطب في عيد الأضحى،
فقال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مُضحٍّ بالجعد بن درهم،
فإنّه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليماً، ولم يتخذ إبراهيم خليلاً.
فنـزل من على المنبر فذبحه؛ لأنه زنديق، فقتله واجب، وشكر ذلك أهل السنة
والجماعة، ولذلك قال ابن القيم في النونية:
ولأجل ذا ضحى بجعدٍ خالـدُ الـ قسري يوم ذبائح القربان
لقد شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قـربان
فخلفه الجهم، فنُسب المذهب إليه؛ لأنه هو الذي أظهره، فجمع بين الجبر
والتجهم.
ولهذا يقول الشاعر:
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم
(226) والقدرية:
مثل نفاه القدر، وهم المعتزلة، يقولون: أفعالُ العباد خلقهم، وليست
داخلةً في خلق الله ولا إرادته، ولذلك سُمُّوا بمجوس هذه الأمة؛ لأن
المجوس أثبتوا خالقين: خالق للخير، وخالق للشر، أما القدرية فأثبتوا
خالقين متعددين مع الله.
(227) وغيرهم، من الذين خالفوا السنة والجماعة، وحالفوا الضلالة:
من الذين خالفوا الكتاب والسنة من سائر الفرق الضالة.
(228) ونحن منهم براء، وهم عندنا ضلال وأرديا. وبالله العصمة
والتوفيق:
فنحن نبرأ منهم، ونعاديهم في الله، ونبغضهم؛ لأنهم أهل ضلال وباطل،
فالواجب هجرهم وبغضهم، والرد عليهم وعلى باطلهم.
فنحن نتبرأ ممن يقول: إن كل الفرق تحت اسم الإسلام، ويجب أن نتغاضى عن
هذه الأمور، أخذاً بحرية الكلمة وحرية الرأي، فالفرق كلها تدخل تحت
الإسلام. وهذا مذهب باطل وخطير على الأمة، وحرية الكلمة والرأي مقيدة
بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. والفرق المخالفة كلها في النار إلا
الفرقة التي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
والإنسان عُرضة للخطأ، العصمة والتوفيق والحول والقوة بيد الله،
فالإنسان لا يضمن لنفسه النجاة، إنما يرجو الله ويخافه.
وبهذا انتهت هذه النبذة المباركة، المشتملة على جُمَل عظيمة من اعتقاد
أهل السنة والجماعة، فنسأل الله أن ينفعنا بها، وأن يجزل لمؤلفها جزيل
الثواب على ما بيّن، وعلى ما وضح وعلى ما كتب، وعلى ما نصح للأمة، فجزاه
الله خيراً وسائر أئمة المسلمين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ا 1
ا 2 ا
3 ا 4
ا 5 ا |